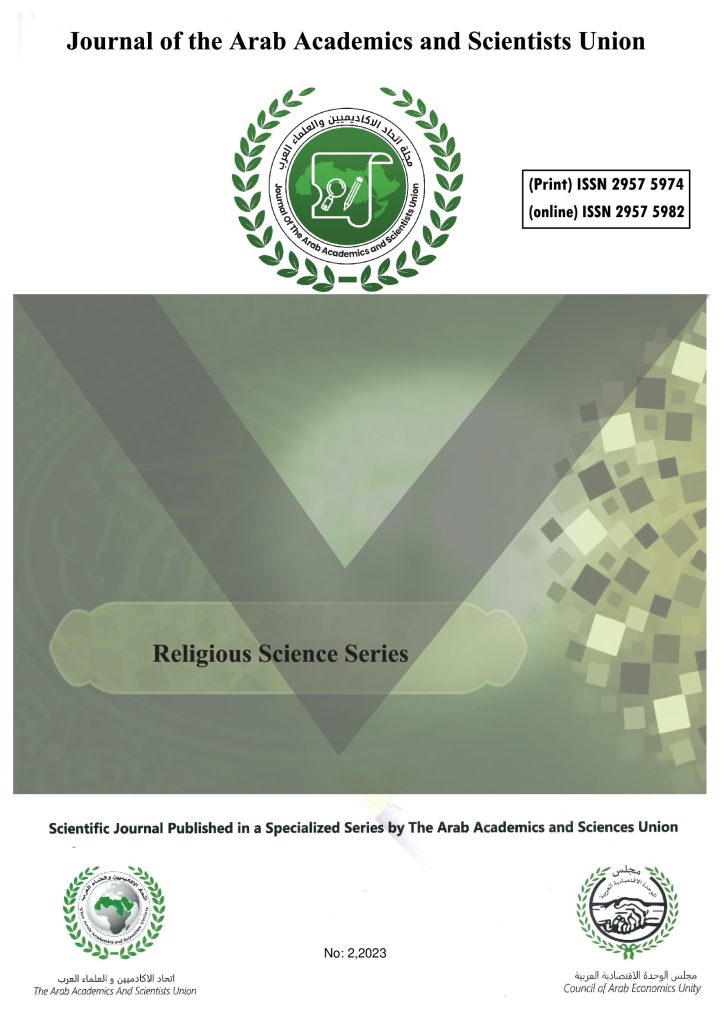سلسلة العلوم الشرعية
العدد: الثاني – عام 2023
الناشر: إتحاد الأكاديميين والعلماء العرب
رقم شهادة الترخيص لدى هيئة الإعلام :
م ن إ / 1495 / مطبوعة متخصصة / 2021
رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية :
د / 3101 / 2022
رقم التصنيف المعياري الدولي :
(Print) ISSN 2957-5974
(online) ISSN 2957-5982
2023 المجلد ، العدد 2
اثر الاختلاف بحجة مفهوم المخالفة على اختلاف الأحكام الفقهية
د. عروه ناصر الدويري
د. اسامه رضوان الجوارنه
د. حارث محمد سلامه العيسى
كلية الشريعة / قسم الفقه وأصوله/ جامعة آل البيت
harithissa@yahoo.com
تاريخ الاستلام: 2022/11/21
تاريخ القبول: 2023/03/04
لقد تحدثت هذه الدراسة عن مسألة هامة من مسائل علم أصول الفقه والتي بنيت عليها أحكام كثير من الفروع والجزئيات الفقهي، وذلك بإتباع المنهجين الاستقرائي، والمقارن التحليلي وهذه الدراسة الموسومة بعنوان: ( أثر الاختلاف بحجية مفهوم المخالفة على اختلاف الأحكام الفقهية) حيث صرح الله سبحانه وتعالى بالأحكام الشرعية بالمنطوق، وثبوت نقيض الحكم المنطوق( المخالف) دليل على اعتبار القيد في حكم المنطوق، حيث تناولت التعريف بمصطلحات الدراسة وبيان حجية مفهوم المخالفة عند العلماء، وتسليط الضوءعلى بعض التطبيقات والفروع الفقهية، نحو: وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة، و جواز الزواج من الفتيات الكتابيات ، والثمر المؤبر يدخل في المبيع إذا بيع النخل أو لا يدخل، ووجوب نفقة المرأة المطلقة الحائل وغيرها من الفروع الفقهية.
الحجية، مفهوم المخالفة، الأحكام الفقهية، دليل الخطاب، أصول الفقه.
المقدمة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من سار على نهجهم واستن بسنتهم إلى يوم الدين وبعد :
يعتبر مفهوم المخالفة من الموضوعات الأصولية التي لها اعتبار في الكتاب والسنة ولغة العرب ويبنى عليها أحكام شرعية ضمن ضوابط وشروط، ويعتبر حجة عند جمهور العلماء، ولما للموضوع من أهمية بارزة في استجلاء بعض الأحكام الشرعية كان هذا البحث كمساهمة متواضعة في سبر غوره والوقوف على معانيه ومراميه.
مشكلة الدراسة :
تكمن مشكلة الدراسة في الإجابة على السؤال الآتي:
هل يثبت عكس الحكم المنطوق للمسكوت عنه أم لا؟ وهل يعتبر مفهوم المخالفة حجة شرعية في بناء الأحكام؟
وهل لمفهوم المخالفة أثر على الأحكام الشرعية؟
أسئلة الدراسة ومحدداتها :
وقد جاءت الدراسة لتجيب على جملة من الأسئلة، هي :
1 هل مفهموم المخالفة حجة شرعية؟.
- ما هي شروط العمل بمفهوم المخالفة ؟
3.ما هي الاثار المترتبة على القول بحجية مفهوم المخالفة؟
أهمية الدراسة :
تتمثل أهمية هذه الدراسة في بيان مفهوم المخالفة، وحجتها؛ وبناء الأحكام على مفهوم المخالفة من الأهمية التي لا يستطيع أحد أن ينكرها؛ من ثبوت عكس حكم المنطوق للمسكوت عنه، حيث يبنى عليه بعض الأحكام الشرعية.
حيث يقع عنوان هذه الدراسة ضمن دائرة اهتمام الطلبة والدارسين في مجالات الفقه وعلم أصول الفقه.
منهجية الدراسة :
سلكنا في دراستنا هذه المنهج العلمي القائم على الاستقراء، والمنهج المقارن التحليلي:
المنهج الاستقرائي: وذلك بتتبع موضوع الدراسة من مصادره، وانعكاسات تلك الدراسة على المجتمع المسلم في كثير من التطبيقات والفروع الفقهية، نحو: وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة، وجواز الزواج من الفتيات الكتابيات، والثمر المؤبر يدخل في المبيع إذا بيع النخل أو لا يدخل، ووجوب نفقة المرأة المطلقة الحائل.
المنهج التحليلي المقارن: وذلك من خلال المقارنة بين أقوال العلماء مسنداً إليها من مظانها، وإجراء المقارنة والتحليل في حجية مفهوم المخالفة، وبعض القضايا الفقهية والجزئيات المعاصرة.
الدراسات السابقة :
هنالك عدة دراسات بحثت مفهوم المخالفة ولكنها جاءت دراسات عامة منها:
دراسة للباحث الدكتور مجيد، محمود شاكر ، والموسومة بعنوان: ” حجية مفهوم المخالفة وشروطه عند الأصوليين ” كلية التربية، مجلة جامعة كركوك للدراسات الإنسانية، جامعة كركوك، المجلد 7، العدد 2، Authentic Concept of the Violation and Conditions When Fundamentalists.
دراسة للباحث أ. سامي محمود أحمد أبو شمعة، والموسومة بعنوان: ” مفهوم المخالفة وأثره في الأحكام في قسم العبادات”، وهي عبارة عن رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 1990م.
خطة البحث :يشتمل البحث مقدمة وتمهيد و خمس مطالب، وخاتمة، وهي :
المقدمة: وبينت فيها أهمية الموضوع وإشكاليته ومنهجية البحث وسبب اختيار الموضوع.
التمهيد وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول : بيان المعنى اللغوي والاصطلاحي لمفهوم المخالفة.
الفرع الثاني: حجية مفهوم المخالفة
الفرع الثالث: شروط مفهوم المخالفة.
المطلب الأول:حكم الزكاة الغنم المعلوفة.
المطلب الثاني:حكم الزواج بالأمة الكتابية.
المطلب الثالث:حكم مطالبة المدين المعسر.
المطلب الرابع:حكم ملكية ثمرة النخيل المبيع قبل تأبيره.
المطلب الخامس: حكم وجوب النفقة على المرأة المطلقة الحائل.
الخاتمة: بينت فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصل اليها البحث.
التمهيد: بيان المعنى اللغوي والاصطلاحي لمفهوم المخالفة وحجيته وشروطه وفيه ثلاثة فروع :
الفرع الاول: تعريف المفهوم لغة واصطلاحاً.
أولاً: تعريف المفهوم لغة.
المفهوم في اللغة: اسم مفعول من فهم الشيء: إذا علمه وعقله، يقال: فَهِمَ الشيء فَهْماً وفَهَماً وفهامة: إذا علمه، وفهمتُ الشيء: عقلته وعرفته([1]).
ثانياً: تعريف المخالفة لغة.
الـمُخالَفةُ الخِلافُ؛ وقال اللحياني: سُرِرْتُ بمَقْعَدي خِلافَ أَصحابي أَي مُخالِفَهم،وخَلْفَ أَصحابي أَي بعدَهم، وقيل: معناه سُرِرْتُ بمُقامي بعدَهم وبعدَ ذهابهم. ابن الأعرابي: الخالِفةُ القاعدِةُ من النساء في الدار ([2]).
ثالثاً: تعريف مفهوم المخالفة اصطلاحا.
فهو ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفاً لمدلوله في محل النطق ويسمى دليل الخطاب أيضاً([3]) ، وعرفه كثير من الأصوليين بأنه: ما فهم من اللفظ في غيره محل النطق ([4]) ويسمى دليل الخطاب؛ لأن دليله من جنس الخطاب، أو لأن الخطاب دال عليه. ([5])
الفرع الثاني: حجية مفهوم المخالفة.
اختلف الاصوليون في حجية مفهوم المخالفة على مذهبين:
المذهب الأول: مذهب الجمهور : ان مفهوم المخالفة حجة ويجب العمل به([6]) المعروف عن الأشعري أنه يقول بحجية مفهوم المخالفة ([7]).
أدلة المذهب الأول:
أولا: من الكتاب:
يقول تعالى: ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۚ ) ([8]) فدلت هذه الآية على أنه لا يصح للرجل ان يتزوج بالأمة اذا كان متزوج من حرة، ويجوز له الزواج بالأمة عند عدم القدرة على الزواج بالحرة؛ وهذا من طريق مفهوم المخالفة.
فهم ابن عباس من قوله تعالى:( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ) ([9]) أن الاخت لا ترث مع البنت. حيث إنه فهم من توريث الأخت مع عدم الولد امتناع توريثها مع البنت لأنها ولد وهو من فصحاء العرب وترجمان القرآن([10]).
سؤال يعلى بن أمية لعمر بن الخطاب :” ما بالنا نقصر وقد أمنا” وقد قال تعالى:( وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا) ([11]).عن يعلى بن أمية قال : قلت لعمر بن الخطاب إنما قال الله ( أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ ) وقد أمن الناس فقال عمر عجبت مما عجبت منه فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته”([12]).
ووجه الاحتجاج به أنه فهم من تخصيص القصر بحالة الخوف عدم القصر عند عدم الخوف ولم ينكر عليه عمر بل قال: لقد عجبت مما عجبت منه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لي:” هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته” ويعلى بن أمية وعمر من فصحاء العرب وقد فهما ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهما عليه([13]). فإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم عمر على تعجبه دليل على حجية مفهوم المخالفة.
قوله تعالى: ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)([14]).
فقوله ” وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ” يدل على تحريم ما ذبح مقترناً بغير اسم الله تعالى كصنم ونحوه، وبمفهوم المخالفة يدل على ان ما ذبح ولم يذكر فيه اسم غير الله فهو حلال.
لما نزل قوله تعالى: ( اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ )([15]) قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد خيرني ربي فوالله لأزيدن على السبعين فعقل أن ما زاد على السبعين بخلافه([16]).
ثانياً : من السنة النبوية المطهرة :
قوله صلى الله عليه وسلم:” لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ”([17])فاحتج ابو عبيد بأن غير الواجد لا يحل عرضه وعقوبته([18]).
قوله صلى الله عليه وسلم:” مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ”([19]) فاحتج ابو عبيد بأن مطل غير الغني ليس بظلم([20]).
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:” لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا”([21])،قال ابو عبيد: فقال لو كان كذلك ، لم يكن لذكر الامتلاء معنى؛ لأن قليله وكثيره سواء فيه، فجعل الامتلاء من الشعر في قوة الشعر الكثير يوجب ذلك، ففهم منه أن غير الكثير ليس كذلك ؛فاحتج به، فقد ألزم من تقدير الصفة المفهوم، فكيف من التصريح بها([22]).
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:” وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها”([23]).فقيد في سائمتها يدل على عدم وجوب الزكاة في المعلوفة، ووجوب الزكاة بالسائمة التي صرح بها الحديث.
أن الصحابة اتفقوا على أن قوله صلى الله عليه وسلم:” إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل “([24]) ناسخ لقوله صلى الله عليه وسلم:” الماء من الماء “([25]) ولولا أن قوله: “الماء من الماء “يدل على نفي الغسل من غير إنزال لما كان نسخاً له ([26]).
أنه قال: صلى الله عليه وسلم “طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعاً” فلو لم يدل على عدم الطهارة فيما دون السبع وإلا لما طهر بالسبع لأن السابعة تكون واردة على محل طاهر فلا يكون طهوره بالسبع ويلزم من ذلك إبطال دلالة المنطوق.
وكذلك إذا قال: “يحرم من الرضاع خمس رضعات “لو لم يدل على أن ما دون ذلك لا يحرم لما كانت الخمس رضعات محرمة لما عرف في الغسلات([27]).
ثالثاً: من المعقول: استدل هذا الفريق بعدد من أدلة المعقول منها([28]):
أولاً: أنه إذا قال العربي لوكيله: اشتر لي عبداً أسود فهم منه عدم الشراء للأبيض حتى إنه لو اشترى أبيض لم يكن ممتثلاً وكذلك إذا. قال الرجل لزوجته: أنت طالق إن دخلت الدار فهم منه انتفاء الطلاق عند عدم الدخول.
ثانياً: أنه لو كان حكم السائمة والمعلوفة سواء في وجوب الزكاة لما كان لتخصيص السائمة بالذكر فائدة بل كان ملغزاً بذكر ما يوهم في الزكاة في المعلوفة ومقصراً في البيان مع دعو الحاجة إليه. وذلك على خلاف الأصل وحيث امتنع ذلك دل على أن فائدة التخصيص بذكر السائمة نفي الزكاة عن المعلوفة.
ثالثاً: إن أهل اللغة فرقوا بين الخطاب المطلق والمقيد بالصفة كما فرقوا بين الخطاب المرسل وبين المقيد بالاستثناء والاستثناء يدل على أن حكم المستثنى على خلاف حكم المستثنى منه فكذلك الصفة.
رابعاً: أنه إذا كان التخصيص بذكر الصفة يدل على الحكم في محل التنصيص وعلى نفيه في محل السكوت كانت الفائدة فيه أكثر مما إذا لم يدل فوجب جعله دليلاً عليه.
خامساً: أن التعليق بالصفة كالتعليق بالعلة والتعليق بالعلة يوجب نفي الحكم لانتفاء العلة فكذلك الصفة.
المذهب الثاني: مذهب الحنفية ان مفهوم المخالفة ليس بحجة ([29]).
أدلة المذهب الثاني: دلت نصوص كثيرة من الكتاب والسنة والمعقول على عدم اعتبار مفهوم المخالفة كحجة؛ نورد منها:
أولاً: من القرآن الكريم :
قال تعالى: ( إنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ)([30]).
فدلت الآية الكريمة على حرمة الظلم في الاشهر الحرم فقط؛ مباح فيما سواه ؛والظلم حرام في كل وقت، فدل على ان مفهوم المخالفة ليس حجة.
قال تعالى: ( وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا )([31]).
فالآية تدل على ان النهي عن الفعل مقيد بالغد، أما بعد يومين أو اكثر فلا يتعلق بالمشيئة، وهذا غير صحيح فكل فعل معلق بالمشيئة في أي وقت، فدل على ان مفهوم المخالفة ليس حجة.
قال تعالى: ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ) ([32]).
فقوله تعالى: ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ) حرم بنت الزوجة اذا كانت في حجر زوج الأم؛ ومباح الزواج بها اذا لم تكن عند زوج الأم، ولم يقل بذلك أحد فدل على ان مفهوم المخالفة ليس حجة.
قال تعالى: ( وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ )([33]).
فدلت الآية على عدم جواز اكراه الفتيات على البغاء اذا اردن العفاف، وبمفهوم المخالفة يجوز اكراههن على البغاء عند عدم ارادة العفاف، وذا غير وارد مطلقاً فالله ينهى عن الفحشاء ولا يأمر بها، فدل على ان مفهوم المخالفة ليس حجة.
ثانياً: من السنة النبوية : عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه”([34]).فيدل على النهي عن البول في الماء الراكد للجنابة، ويفيد الغسل منه بغير الجنابة، والحق انه منهي عنه للجنابة وغيرها.
ثالثاً: من المعقول: استدلوا بعشرة أدلة([35]):
أولاً: أن تقييد الحكم بالصفة لو دل على نفيه عند نفيها إما أن يعرف ذلك بالعقل أو النقل والعقل لا مجال له في اللغات والنقل إما متواتر وآحاد ولا سبيل إلى التواتر والآحاد لا تفيد غير الظن وهو غير معتبر في إثبات اللغات لأن الحكم على لغة ينزل عليها كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بقول الآحاد مع جواز الخطأ والغلط عليه يكون ممتنعاً.
ثانياً: أنه لو كان تقييد الحكم بالصفة يدل على نفيه عند عدمها لما حسن الاستفهام عن الحكم في حال نفيها لا عن نفيه ولا عن إثباته لكونه استفهاماً عما دل عليه اللفظ كما لو قال: له لا تقل لزيد أف فإنه دل على امتناع ضربه فإنه لا يحسن أن يقال: فهل أضربه ولا شك في حسنه لو قال: أد الزكاة عن غنمك السائمة فإنه يحسن أن يقال وهل أؤديها عن المعلوفة ؟
ثالثاً: لو كان تعليق الحكم على الصفة يدل على نفيه عن غير المتصف بها لكان في الخبر كذلك ضرورة اشتراك الأمر والخبر في التخصيص بالصفة واللازم ممتنع.
ولهذا فإنه لو قال: رأيت الغنم السائمة ترعى فإنه لا يدل على عدم رؤية المعلوفة منها.
رابعاً: أن أهل اللغة فرقوا بين العطف والنقض فقالوا: قول القائل: اضرب الرجال الطوال والقصار فالقصار عطف وليس بنقض للأول ولو كان قوله: اضرب الرجال الطوال مقتضياً لنفي الضرب عن القصار لكان نقضاً لا عطفاً وهي بعيدة عن التحقيق.
خامساً: أنه لو كان تعليق الحكم بالصفة دالاً على نفيه عن غير الموصوف بها لما حسن الجمع بين قوله: أد زكاة السائمة وبين قوله: والمعلوفة لما بينهما من التناقض كما لا يحسن أن يقول له: لا تقل لزيد أف واضربه.
سادساً: ذكرها أبو عبد الله البصري والقاضي عبد الجبار وهي أن المقصود من الصفة إنما هو تمييز الموصوف بها عما سواه.
وكذلك المقصود من الاسم إنما هو تمييز المسمى عن غيره وتعليق الحكم بالاسم كما لو قال: زيد عالم لا يدل على نفي العلم عمن لم يسم باسم زيد فكذلك تعليق الحكم بالصفة.
سابعاً: أن تعليق الحكم بالصفة لا يدل على نفيه عن غير الموصوف بها لأنه يصح أن يقال: في الغنم السائمة زكاة ولا زكاة في المعلوفة منها ولو كان قوله: في الغنم السائمة زكاة يدل على نفيها عن المعلوفة لما احتيج إلى العبارة الأخرى لعدم فائدتها.
ثامناً: أن القول في الغنم السائمة زكاة له دلالة بمنطوقه على وجوب السائمة فلو كان له دلالة مفهوم لجاز أن يبطل حكم المنطوق ويبقى حكم دلالة المفهوم كما يجوز أن يبطل حكم دليل الخطاب ويبقى حكم صريح الخطاب وهو ممتنع.
تاسعاً: أنه ليس في لغة العرب كلمة تدل على المتضادين معاً فلو كان قوله في الغنم السائمة زكاة دالاً على نفي الزكاة عن المعلوفة لكان اللفظ الواحد دالاً على الضدين معا وهو ممتنع.
عاشراً: أن صورة الغنم السائمة مخالفة لصورة الغنم التي ليست بسائمة وعند اختلاف الصورتين لا يلزم من ثبوت الحكم في أحديهما ثبوته في الأخرى ولا عدمه لجواز اشتراك الصور المختلفة في أحكام وافتراقها في أحكام.وإذا لم يكن ذلك لازماً لم يلزم من الإخبار عن حكم في إحدى الصورتين الإخبار عنه في الصورة الأخرى لا وجوداً ولا عدماً.
وبعد عرض آراء المذاهب وأدلتها يتبين أن رأي الجمهور هو الراجح لما يلي:
أن القول بمفهوم المخالفة يتفق مع المنطق البياني السليم،لأن الوصف أو الشرط أو الغاية لا يمكن أن تذكر لغير سبب، وإلا كان عبثاً، والشارع منزه عن العبث.
ما أورده الحنفية من أدلة من الكتاب والسنة ،فيها مقاصد أخرى، مقاصد بيانية من ترغيب او تنفير أو مرعاة لاعراف الناس،فإن اخرجت هذه المقاصد لم يبقى إلا العمل بمفهوم المخالفة.
ما شرطه الجمهور من شروط للعمل بمفهوم المخالفة يدحض معظم الادلة التي استدل بها الحنفية.
قوة أدلة الجمهور وسلامتها من المعارضة وضعف أدلة الحنفية ومناقشتها.
يقول الآمدي:” إنه لو كان تعليق الحكم على الصفة موجباً لنفيه عند عدمها لما كان ثابتاً عند عدمها لما يلزمه من مخالفة الدليل. وهو على خلاف الأصل لكنه ثابت مع عدمها ودليله قوله تعالى: ( ولَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا) ([36]) فإن النهي عن قتل الأولاد وقع معلقاً على تحريم القتل حالة الإملاق وكان التنصيص أولى من التحريم حالة خشية عدم خشية الإملاق بخشية الإملاق وهو منهي عنه أيضاً في حالة عدم خشية الإملاق. فإن قيل: تعليق الحكم بالصفة عندنا إنما يكون دليلاً على نفيه حالة عدم الصفة إذا لم يكن حالة عدم الصفة أولى بإثبات حكم الصفة كما ذكرناه من حكم زكاة السائمة والمعلوفة. وأما إذا كان الحكم في حالة عدم الصفة أولى بالإثبات من حالة وجود الصفة فلا وها هنا تحريم القتل حالة عدم خشية الإملاق أولى من التحريم حالة خشية الإملاق فكان التنصيص على تحريم القتل حالة خشية الإملاق محرماً له حالة عدم الخشية بطريق الأولى وكان ذلك من باب فحوى الخطاب لا من باب دليل الخطاب. قلنا: هذا وإن استمر لكم في هذه الصورة فلا يستمر في قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ )([37]) وفي قوله: ( وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا)([38]) وفي قوله تعالى: (وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ )([39])فإن النهي في جميع هذه الصور ليس هو أولى من صور السكوت فإن النهي. عن أكل قليل الربا ليس أولى من كثيره ولا النهي عن أكل مال اليتيم من غير إسراف أولى من الإسراف ولا النهي عن الإكراه على الزنى حالة إرادة التحصن أولى من حالة إرادة الزنى ومع ذلك فالحكم في الكل مشترك. فإن قيل مخالفة دليل الخطاب في هذه الصور إنما كانت لمعارض ولا يلزم مخالفته عند عدم المعارض قلنا: وإن كان ثبوت الحكم في صورة السكوت على نحو ثبوته في صورة النطق لدليل ولكن يجب أن يعتقد أنه من غير مخالفة دليل لما فيه من دفع محذور المعارضة ولو كان دليل الخطاب دليلا لزم من ذلك التعارض وهو خلاف الأصل.
المسلك الثاني إن تعليق الحكم بالصفة لو كان مما يستفاد منه نفي الحكم عند عدم الصفة لم يخل إما أن يكون ذلك مستفاداً من صريح الخطاب أو من جهة أن تعليق الحكم بالصفة يستدعي فائدة ولا فائدة سوى نفي الحكم عند عدم الصفة أو من جهة أخرى الأول محال فإن صريح الخطاب بوجوب الزكاة في السائمة غير صريح بوجوبها في المعلوفة كيف وإن ذلك مما لا قائل به.
والثاني أيضاً ممتنع لما ذكرناه من الوجوه الكثيرة في إبطال الحجة الأولى من المعقول للقائلين بدليل الخطاب.
والثالث فالأصل عدمه وعلى مدعيه بيانه ويلتحق بهذه المسألة تخصيص الأوصاف التي تطرأ وتزول كقوله: السائمة تجب فيها الزكاة والحكم كالحكم نفيا وإثباتا والمأخذ من الطرفين فعلى ما عرف والمختار فيها كالمختار ثم”([40]). متأخرو الحنفية يقولون بمفهوم المخالفة: فقد أورد صاحب التقرير والتحبير:” والحنفية ينفونه” أي اعتبار مفهوم المخالفة “بأقسامه في كلام الشارع فقط” فقد نقل الشيخ جلال الدين الخبازي في حاشية الهداية عن شمس الأئمة الكردري أن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه في خطابات الشارع فأما في متفاهم الناس وعرفهم، وفي المعاملات والعقليات يدل”([41]). فهذا يدل على حجية مفهوم المخالفة في تعامل الناس وأقولهم.
الفرع الثالث: شروط مفهوم المخالفة.
وللعمل بمفهوم المخالفة عند من اعتبره حجة شُرُوط ([42]):
ألا يعارضه ما هو أرجح منه، من منطوق أو مفهوم موافقة، أما إذا عراضه قياس، فلم يجوز القاضي أبو بكر الباقلاني ترك المفهوم به، مع تجويزه ترك العموم بالقياس.
ألا يكون المذكور قصد به الامتنان، نَحْوَ قَوْلِهِ -جَلَّ وَعَلا: (لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا) ([43]) فَلا يَدُلُّ عَلَى مَنْعِ الْقَدِيدِ مِنْ لَحْمِ مَا يُؤْكَلُ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ الْبَحْرِ كَغَيْرِهِ،ولا يدل على منع أكل ما ليس بطري.
ألا يكون المنطوق خرج جوابا عن سؤال متعلق بحكم خاص، ولا حادثة خاصة بالمذكور،قال: ومن أمثلته قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) ([44]) فلا مفهوم للأضعاف؛ لأنه جاء على النهي عما كانوا يتعاطونه بسبب الآجال، كان الواحد منهم إذا حل دينه يقول: إما أن تعطي، وإما أن تربي، فيتضاعف بذلك أصل دينه مرارا كثيرة، فنزلت الآية على ذلك.
ألا يكون المذكور قصد به التفخيم، وتأكيد الحال، كقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا “([45]) الحديث، فإن التقييد “بالإيمان” لا مفهوم له، وإنما ذكر لتفخيم الأمر.
أن يذكر مستقلا، فلو ذكر على وجه التبعية لشيء آخر، فلا مفهوم له، كقوله تعالى: ( وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا )([46])فإن قوله تعالى: (فِي الْمَسَاجِدِ) لا مفهوم له؛ لأن المعتكف ممنوع من المباشرة مطلقًا.
ألا يظهر من السياق قصد التعميم، فإن ظهر فلا مفهوم له، كقوله تعالي: ( وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) ([47])، للعلم بأن الله سبحانه قادر على المعدوم، والممكن. وليس بشيء، فإن المقصود بقوله تعالى: ( عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) التعميم.
ألا يعود على أصله الذي هو المنطوق بالإبطال، أما لو كان كذلك فلا يعمل به.
ألا يكون قد خرج مخرج الأغلب، كقوله تعالى:(وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ)([48]) فإن الغالب كون الربائب في الحجور، فقيد به لذلك، لا لأن حكم اللاتي لسن في الحجور بخلافه، ونحو ذلك كثير في الكتاب والسنة.
المطلب الأول: حكم الزكاة في الغنم المعلوفة.
الخطاب الدال على حكم مرتبط باسم عام مقيد بصفة خاصة كقوله صلى الله عليه وسلم:” في الغنم السائمة زكاة ” هل يدل على نفي الزكاة عن غير السائمة أو لا ؟
اختلف الفقهاء في زكاة المعلوفة على مذهبين:
المذهب الأول : ما ذهب إليه جمهور الفقهاءالحنيفة([49])،والشافعية([50])،والحنابلة([51]) من عدم وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة.
المذهب الثاني : ما ذهب إليه المالكية([52]) أن الزكاة تجب في السائمة والمعلوفة.
الأدلة:
اولا:أدلة ( الجمهور) المذهب الأول:احتج الجمهور لرأيهم بعدم وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة بالأدلة الآتية.
بمفهوم قوله(صلى الله علية وسلم) :”في سائمة الغنم زكاة اذا كانت اربعين ففيهاً شاه الى مائة”([53]).
مفهوم قوله (صلى الله عليه وسلم) :”وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومائة شاه”([54]).
وجه الدلالة: دل الحديثان بمفهومها على نفي الزكاة في معلوفة الغنم([55]) وتفصيل ذلك:ان الحديثين يدلان بمفهومهما على وجوب الزكاة في الغنم السائمة ، ويدلان بمفهومهما اي مفهوم المخالفة على عدم وجوب الزكاة المعلوفة. او بطريقة أخرى: ان الحديثين دلّا بمنطوقهما على وجوب الزكاة في الغنم السائمة فقط، وهذا يفهم منه عدم وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة.
ان السبب في إيجاب الزكاة المال النامي، ودليل النماء الإسامة للدر والنسل او الأعتداد للتجارة وتكثر وتزداد المؤنه وفي المعلوفة فلم يوجد النماء معنىً([56]).
أدلة المذهب الثاني:
المالكية :-
حيث احتج المالكية القائلون بوجوب الزكاة بالغنم المعلوفة كما تجب في السائمة بالأدلة الآتية.
قوله (صلى الله عليه وسلم):” وفي الغنم في كل أربعين شاه الى عشرين ومائة شاه”([57]).
وجه الدلالة: أن الحديث ورد عاماً في أيجاب الزكاة وهو أقوى من المفهوم في الاحتجاج لذا أخذوا في كل أربعين شاه. في أيجاب الزكاة في السائمة والمعلوفة([58]).
السنة النبوية :
حديث في سائمة الغنم الزكاة، ورد التقييد بالسوم الوارد في الحديث أنما هو خرج مخرج الغالب، لأن الغلب في مواشي العرب أنها سائمة أي تعتمد على الرعي، فالتقييد بالسائمة جاء لبيان الواقع لا مفهوم له. ([59]).
من جهة أخرى إن الحديث خرج على سؤال سائل، هل في سائمة الغنم زكاة فقال: وفي سائمة الغنم زكاة، فكان مقصوراً على سببه، وأنتفى بذلك أن يكون فيه دليل على أنه لا زكاة في المعلوفة([60]).
الخلاصة:
نلحظ أن الاختلاف بمفهوم المخالفة كان له أثرٌ واضحٌ في اختلاف الفقهاء في الحكم الشرعي ، حيث ذهب الجمهور
بناءً على حجية مفهوم الصفة لم يوجبوا الزكاة في المعلوفة والا لما كان لذكر قيد السوم معنى.
وذهب الحنفية الى وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة،بناء على عدم اعتبارهم مفهموم المخالفة (مفهوم الصفة) حجة.
المطلب الثاني: حكم الزواج من الفتيات الكتابيات([61]).
يقول تعالى: ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ)([62]) فدلت هذه الآية على أنه لا يصح للرجل ان يتزوج بالأمة اذا كان متزوج من حرة، ويجوز له الزواج بالأمة عند عدم القدرة على الزواج بالحرة؛ وهذا من طريق مفهوم المخالفة.
اختلف الفقهاء في هذه المسالة على رأيين:
الرأي الأول: ذهب إليه جمهور الفقهاء المالكية([63])، والشافعية([64])، والحنابلة([65]) ، حيث قالوا بعدم جواز الزواج من الفتايات الكتابيات.
الرأي الثاني: حيث ذهب الحنفية الى القول بجواز الزواج من الفتاة الكتابية .
الادلة:
اولاً:استدل الجمهور القائل بعدم جواز نكاح الأمة الكتابية بـ:
قوله تعالى: ( وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم ۚ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ۚ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ ۚ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)([66]) وجه الدلالة:دلت الآية الكريمة بمطوقها على جواز نكاح الأمة المؤمنة في حال عدم القدرة على الزواج من المحصنات الحرائر ودلت بمفهومها على عدم جواز نكاح الأمة الكتابية ([67]).
وتوضيح ذلك: بما أن الآية الكريمة أجازت الزواج من الامة المؤمنة في حال عدم القدرة على الحره فهذا يفهم منه أن الامة الكتابية لا يجوز نكاحها. والجمهور عندما لم يجزوا نكاح ألامه الكتابية وذلك تبعاً لمنهجهم الأصولي في الاحتجاج بمفهوم المخالفة.
استدل الجمهور ثانياً: أن الأمة قد تكون ملكاً للكافر، فعلى القول بالجواز فالولد الحادث اذاً كان ملكاً لسيد الأمة، فذلك يوجب ابتداءً ملك النصراني للمسلم وذلك غير جائز([68]).
ثانياً:أدلة الرأي الثاني الحنفية:
استدل الحنفية لقولهم بجواز نكاح الأمة الكتابية بقوله تعالى: ( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ) ([69]).
وجه الدلالة:أن لفظ النساء لفظ عام فتدخل تحته الإماء والحرائر وبناءً عليه يجوز نكاح الإماء من المؤمنات والكتابيات([70]).
إن منهج الحنفيه في عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة وبتالي كان لمنهجهم أثر في اختلاف الحكم حيث أنهم يجيزون نكاح الأمة الكتابية أما الذين اعتبروا ان مفهوم المخالفة حجة فقد منعوا الزواج بالأمة الكتابية.
الخلاصة: إن منهج الحنفيه في عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة كان له أثر في اختلاف الحكم حيث أنهم يجيزون نكاح الأمة الكتابية أما الذين اعتبروا ان مفهوم المخالفة حجة فقد منعوا الزواج بالأمة الكتابية. الزواج من الفتيات الكتابيات فقد اختلف فيه: ذهب الجمهور الى عدم الجواز بناءً على حجية مفهوم الصفة، فقيد” مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ” فالآية جعلت الايمان من الاوصاف المعتبرة ينتفي الحل بانتفائه، وعلى ذلك لا يجوز الزواج بالفتيات الكتابيات. وذهب الحنفية الى جواز النكاح، لانهم لا يقولون بحجية مفهوم الصفة. فنلحظ أن الاختلاف بمفهوم المخالفة كان له أثرٌ واضحٌ في اختلاف الفقهاء في الحكم الشرعي.
المطلب الثالث: حكم مطالبة المدين المعسر.
اختلف العلماء في هذه المسألة بما يتعلق بملازمة المدين المعسر على رأيين:
الرأي الأول: ذهب جمهور الفقهاء ([71]) (الصاحبان من الحنفيه والمالكية والشافعية والحنابلة ) الى القول بعدم ملازمة المدين المعسر وأن يترك الى حين يساره.
الرأي الثاني: يجوز ملازمة المدين لمعسر مع أنه يستحق الانظار وهذا ما ذهب اليه أبو حنيفة رحمه الله([72]).
الأدلــــــة: استدل الجمهور بالأدلة الآتية:- ( لقولهم بعدم جواز ملازمة المدين المعسر).
أولاً:قوله تعالى: ( وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ) ([73]).
وجه الدلالة([74]) : دلت الآية الكريمة على أن الله تعالى اوجب الانظار (الإمهال) للمدين المعسر الى وقت يساره وهذا يعني عدم ملازمة المدين المعسر الى حين يساره ويفهم منه أيضا اذا كان المدين غنياً فأنه يجوز حبسه ومطالبته ” وهذا يدل على حجية الأخذ بمفهوم المخالفة.
ثانياً: استدل الجمهور بقوله(صلى الله عليه وسلم):” مطل الغنى ظلم وإن اتبع أحدكم على مليء فليتبع”([75]). والحديث الشريف يدل بمفهومة على أن فضل المدين المعسر لا يعد ظلماً ولا يحل مطالبته ولا ملازمته الى حين يساره([76]).
ثالثاً: قوله صلى الله عليه وسلم:”من أنظر معسراً أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله” ([77]).
وجه الدلالة: دل الحديث على الفضل العظيم المترتب على انظار المدين المعسر وهذا فيه دلاله على عدم ملازمته الى وقت يساره([78]).
أدلة الرأي الثاني:
احتج الإمام ابو حنيفة بأنه لا يجوز ملازمة المدين المعسر من قبل أصحاب الدين بما يأتي:-
قوله(صلى الله عليه وسلم) الصاحب الحق اليد واللسان) ([79]) . وجه الدلالة:- يدل الحديث على حق الدائنين على ملازمة المدين المعسر لأن اليد تعني الملازمة واللسان تعني التقاضي ويأخذون فضل كسبه ويقسم بينهم لاستواء حقوقهم في القوة ([80]).
الدليل الثاني لابي حنيفة رحمه الله تعالى:-” أن المدين منتظر الى زمان قدرته على الايفاء وذلك ممكن في كل ساعة فيلازمونه كي لا يخفيه”([81]).وأبو حنيفة رحمه الله لا يقول بلمفهوم المخالفة وان قال بعدم حبس المدين المعسر الا انه ذهب الى ان للدائنين الحق بملازمة المدين المعسر لعله يكسب ومن ثم يقومون باستيفاء حقهم منه([82]).
الخلاصة: فنلحظ أن الاختلاف بمفهوم المخالفة كان له أثرٌ واضحٌ في اختلاف الفقهاء في الحكم الشرعي حيث اوجب اجمهور انظار المدين المعسر الى وقت يساره وهذا يعني عدم ملازمة المدين المعسر الى حين يساره، ويفهم منه أيضا اذا كان المدين غنياً فأنه يجوز حبسه ومطالبته وهذا يدل على حجية الأخذ بمفهوم المخالفة.أما منهج الحنفيه في عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة ادى الى اختلاف الحكم حيث قالوا بجواز ملازمة المدين لمعسر مع أنه يستحق الانظار.
المطلب الرابع: حكم ملكية ثمرة النخيل المبيع قبل تأبيره([83]).
صورة المسألة:هل لتأبير النخيل اثر في ملكية الثمرة للبائع أو لا؟
اختلف الفقهاء في مسألة ملكية ثمرة النخيل قبل التأبير على مذهبين:
المذهب الأول:أن من باع نخلا بعد التأبير فثمرتها للبائع إلاّ أن يشترط المبتاع،وهذا ما ذهب اليه المالكية([84]) والشافعية([85]) والحنابلة([86]).
المذهب الثاني:أن ثمرة النخيل للبائع في الحالتين سواء قبل التأبير أو بعده،وهذا ما ذهب اليه الحنفية([87]).
الأدلة:
أولاً: أدلة الجمهور:
حيث استدل الجمهور بالأدلة الآتية:
قول النبي صلى الله عليه وسلم:” من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذى باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا فماله للذى باعه إلا أن يشترط المبتاع”([88])،وجه الدلالة في الحديث:دلّ الحديث بمنطوقه على أن الثمرة المؤبرة للبائع، ودلّ بمفهوم المخالفة أن الثمرة قبل التأبير للمشتري ([89])،وإلا ما كان لذكر قيد التأبير في الحديث معنى.
قال الشافعي:فإذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإبار حداً لملك البائع،فقد جعل ما قبله حداً لملك المشتري([90]).
ولأن الثمرة قبل التأبير نماء كامن لظهوره غاية،فيتبع الأصل قبل ظهوره، ولم يتبعه بعده كالحمل([91]).
ثانياً: أدلة الحنفية:
حيث استدل الحنفية بالأدلة الآتية:
قول النبي صلى الله عليه وسلم:” من اشترى أرضا فيها نخل فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع” ([92]).
وجه الدلالة في الحديث: حيث دلّ الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الثمرة للبائع مطلقاً عن وصف أو شرط، فدل على أن الحكم لا يختلف بالتأبير وعدمه([93])،سواء كان البيع قبل التأبير أو بعده.
لقد رد الحنفية على استدلال الجمهور بحديث النبي صلى الله عليه وسلم:” من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذى باعها إلا أن يشترط المبتاع ” أن تقييد الحكم بوصف لا يدل على أن الحكم في غير الموصوف بخلافه، بل يكون الحكم فيه مسكوتاً موقوفاًعلى قيام الدليل،ويقصدون بذلك الحديث” من اشترى أرضا فيها نخل فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع”،فقد قام الدليل.
قالوا بأنه لا يفصل في الحكم بين المؤبر وغير المؤبر،أما قبل التأبير فلأن الملك ثابت للبائع في الشجرة والثمرة قبل البيع، والبيع اضيف الى الشجرة فيقتصر حكمه عليه، والحديث الشريف لم يتعرض لما قبل التأبير بنفي أو إثبات فبقي على أصل ملك البائع([94]).أما ملكية البائع للثمرة بعد التأبير فللحديث المروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:” من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع”([95]).
الخلاصة: فنلحظ أن الاختلاف بمفهوم المخالفة كان له أثرٌ واضحٌ في اختلاف الفقهاء في الحكم الشرعي،حيث ذهب الجمهور بناءً على حجية مفهوم الصفة ان الثمر يدخل في المبيع عند بيع النخل، ويصبح في ملك المشتري، حيث اخذ الجمهور بمفهوم الحديث حين جعل التأبير حداً لملك البائع للثمرة، فيكون ما قبله للمشتري والا لم يكن ذكر التأبير مفيداً. وذهب الحنفية الى ان ثمر النخل لا يدخل في بيعه سواء أكان مؤبراً أم غير مؤبر، بناء على عدم الاخذ بمفهوم الصفة فقيد التأبير لا يدل على نفي الحكم عند عدمه.
المطلب الخامس: حكم وجوب نفقة المرأة المطلقة الحائل.
صورة المسألة:اذا طلقت المرأة بائنا ولم تكن حاملاً فهل تجب لها النفقة على طليقها؟
اختلف الفقهاء في مسألة وجوب نفقة المرأة المطلقة الحائل على مذهبين:
المذهب الأول: ليس للمرأة المطلقة الحائل نفقة ،وهذا ما ذهب اليه المالكية([96]) والشافعية([97]) والحنابلة([98]).
المذهب الثاني: وجوب النفقة للمرأة المطلقة الحائل ،وهذا ما ذهب اليه الحنفية([99]).
الأدلة:
أولاً: أدلة الجمهور: استدل الجمهور:
بقوله تعالى: ( وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ)([100]).
ووجه الاستدلال: الى ان الله سبحانه وتعالى علق وجوب النفقة بشرط الحمل، وتنتفي النفقة عند عدم الحمل، فالحائل لا نفقة لها نفقة الحائل لا تجب بناءً على حجية مفهوم الشرط. و الحائل لو كانت كالحامل في وجوب النفقة لم يبق لتخصيص الحامل في النص فائدة.
ثانيا: أدلة الحنفية:
حيث استدل الحنفية: بقوله تعالى: ( سْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ)([101])، ووجه الاستدلال: عرفنا وجوب نفقة الحامل بالنص وهو قوله تعالى (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) والدليل على أنه في المطلقات آخر الآية وهو قوله تعالى (حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)، والنفقة في غير المطلقات غير مغياة بوضع الحمل([102]).و اعترض عليه بأن الحائل لو كانت كالحامل في وجوب النفقة لم يبق لتخصيص الحامل في النص فائدة .
وأجيب بأن الفائدة رفع الاشتباه ، وبيانه أن الحائل تستحق النفقة ثلاثة قروء ، وكان يشتبه بأن الحامل أيضا تستحق ذلك المقدار أو زيادة فرفع ذلك وقال : لها النفقة في جميع مدة الحمل حتى يضعن حملهن([103]) .
الخلاصة: فنلحظ أن الاختلاف بمفهوم المخالفة كان له أثرٌ واضحٌ في اختلاف الفقهاء في الحكم الشرعي،حيث ذهب الجمهور بناءً على حجية مفهوم الشرط الى عدم وجوب النفقة للمرأة المطلقة الحائل.
وذهب الحنفية الى وجوب النفقة للمرأة المطلقة ثلاثاً سواءً أكانت حاملاً أو حائلاً ، بناء على عدم الاخذ بمفهوم الشرط فقيد الحمل لا يدل على نفي الحكم عند عدمه. فتبقى النفقة للحائل لانها في عدة محتبسة بسبب الزواج، ووجبت النفقة للزوجة لاحتباسها.
الخاتمة:
حيث اشتملت الدراسة على أهم النتائج والتوصيات الآتية:
النتائج:
بيان أن مفهوم المخالفة حجة شرعية معتبرة في بناء الأحكام.
ظهر أثر الاختلاف في مفهوم المخالفة في كثير من الفروع الفقهية منها:
وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة، جواز الزواج من الفتيات الكتابيات، الثمر المؤبر يدخل في المبيع اذا بيع النخل أو لا يدخل، و وجوب نفقة المرأة المطلقة الحائل وغيرها من الفروع الفقهية.
يتبين لنا أن لمفهوم المخالفة أثر في تغير الحكم الشرعي.
لمفهوم المخالفة أثر في خلاف الفقهاء رحمهم الله.
التوصيات:
نوصي بتناول طلاب العلم مفهوم المخالفة بالدراسة والبحث حيث أن مضامينه واسعة، تحتاج لمن يسبر غورها من طلبة الماجستير والدكتوراة، بالدراسة التفصيلية التطبيقية.
قائمة المصادر و المراجع:
- أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، دار الجيل ،1420هـ.
- ابن منظور الافريقي، لسان العرب، دار صادر بيروت.
- علي بن ابي علي بن سالم التغلبي سيف الدين الامدي (631ه- 1233 م)، الاحكام في أصول الأحكام ، ضبطه وكتب حواشيه؛ابراهيم العجوز،منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان .
- ابن الحاجب المالكي (674ه-1275م)، مختصر المنتهى الأصولي مع شرح العضد، الطبعة الثانية، دار الكتب، بيروت، لبنان، (1983م.
- ابو الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الاصبهاني، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، دار المدني، 1406هـ.
- علي بن عبد الكافي السبكي(706هـ)،جمع الجوامع مع شرح المحلي،تحقبق مكتبة الكليات الأزهرية،القاهرة،الطبعة الأولى،(1981م.
- ابن النجار،محمد بن أحمد بن عبد العزيز علي الفتوحي الحنبلي،شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير،تحقيق محمد الزحيلي،نزيه حماد،مركز البحث العلمي وإحياء التراث،جامعة أم القرى،مكة المكرمه،دار الفكر،دمشق،الطبعة الاخيرة،1982م.
- محمد بن علي الشوكاني (1255ه-1839 م)، ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الاصول ،دار المعرفة، بيروت،لبنان.
- سعد الدين التفتازاني (791ه- 1388م)، حاشية التفتازاني وحاشية الشريف الجرجاني، (816ه-1413هـ) على شرح العضد (756ه-1355م) لمختصر المنتهى الاصولي لابن الحاجب المالكي (674ه-1275م)،ج2ص173، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، (1983م).
- الغزالي،المستصفى من علم الأصول ومعه كتاب فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقه للإمام الحنفي ابن عبد الشكور،المطبعة الاميرية،بولاق،مصر،القاهرة،الطبعة الأولى،1985م.
- القاضي أبو يعلى ، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء (458هـ)، العدة في أصول الفقه، تحقيق د أحمد بن علي بن سير المباركي، الطبعة الثانية ، (1410 هـ – 1990 م).
- الترمذي،محمد بن عيسى بن سورة (279هـ)، الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل، وهو جامع الترمذي ،دار السلام للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، بإشراف ومراجعة صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، السعودية،الرياض، (1440هـ-1999م) ،.
- النسائي،ابي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان (303هـ) ،سنن النسائي الصغرى المجتبى من السنن، دار السلام للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، بإشراف ومراجعة صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، السعودية،الرياض، (1440هـ-1999م) .
- محمد بن إسماعيل البخاري (194هـ-256هـ)، صحيح البخاري المسمى( الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه)، دار السلام للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، بإشراف ومراجعة صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، السعودية، الرياض، (1440هـ-1999م).
- مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، (261ه- 874 م)، صحيح مسلم(المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم)، دار السلام للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى ، بإشراف ومراجعة صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، السعودية-الرياض، (1440هـ-1999م) .
- ابن امير الحاج، التقرير والتحبير، المطبعة الاميرية،بولاق،مصر،القاهرة،دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان،الطبعة الثانية،1983م.
- عبد العلي محمد بن نظام الدين، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقه،المطبعة الاميرية،بولاق،مصر،القاهرة،الطبعة الأولى،1985م .
- ابن نجم الحنفي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ط2، دار الكتاب الاسلامي.
- عثمان بن علي، الزيلعي، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق ، المطبعة الاميرية الكبرى، القاهرة(1313هـ).
- الماوردي،ابوالحسين علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي(450هـ)، الحاوي الكبير في مذهب الإمام الشافعي وهو شرح المزني، دار الفكر، بيروت.
- الغزالي،أبو حامد محمد بن محمد الطوسي(505هـ)، الوسيط في المذهب، تحقيق: احمد محمود ابراهيم ومحمد محمد تامر، الطبعة الاولى، دار السلام، القاهرة، (1417هـ) .
- الجمل، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري(1204هـ)، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل، دار الفكر، بيروت.
- منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن ادريس البهوتي الحنبلي(1051هـ)، كشاف القناع على متن الاقناع ، دار الكتب العلمية.
- منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن ادريس البهوتي الحنبلي(1051هـ)، الروض المربع شرح زاد المستقنع،دار المؤيد ،مؤسسة الرسالة.
- الخرشي،محمد بن عبدالله المالكي أبوعبدالله(1101هـ)،شرح مختصر خليل للخرشي ، دار الفكر للطباعة، بيروت.
- القرطبي،أبو الوليد محمد بن احمد بن رشد(520هـ)،البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، تحقيق د. محمد حجي واخرون،ط2، دار العرب الإسلامي، بيروت ،لبنان، (1408هـ -1988 م).
- أبو عبدالله الحاكم محمد بن عبدالله بن محمد النسابوري المعروف بابن البيع(405هـ)، المستدرك على الصحيحين،تحقيق مصطفى عبدالقادر عطا، طـ1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،(1411هـ-1990م).
- التنوخي، قاسم بن عيسى بن ناجي بن علي بن موسى الخسروجردي الخرساني أبوبكر(458هـ)، شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة، والمتن لعبدالله بن عبد الرحمن القيرواني، تحقيق احمد مزيد المزيدي،ط،1 (1428هـ-2007م).
- الرجراجي، مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، تحقيق أبو الفضل الدمياطي ط1، دار ابن حزم (1428هـ- 2007م).
- النووي،أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي(676هـ)،المجموع شرح المهذب للشيرازي،دار الفكر.
- ابن قدامه،أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي(620هـ)، المغني ،تحقيق عبدالله بن عبد المحسن التركي و عبد الفتاح محمد الحلو، الطبعة الثالثة، عالم الكتب، الرياض،(1417هـ/1997م) .
- نور الدين أبي طالب عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم بن علي بن عثمان البصري الضرير(684هـ)،الواضح في شرح مختصر الخرقي،الطبعة الأولى،تحقيق عبد الملك بن عبدالله دهيش،دار خضر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، (2000م).
- القاضي عبد الوهاب البغدادي،أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي(422هـ)، المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس،تحقيق حميش عبد الحق،المكتبة التجارية،مصطفى أحمد الباز،مكة المكرمة.
- زكريا محمد بن زكريا الانصاري(926هـ)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، دار الكتاب العربي.
- مصطفى بن سعد السيوطي الرحبياني(1243هـ)،مطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى،ط2، المكتب الاسلامي، (1415هـ – 1994م).
- علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي. سنن الدارقطني، ط1، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان (1424هــ- 2004م).
- النفراوي،أحمد بن غانم بن سالم بن مهنا الازهري المالكي(1126هـ)،الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني،دار الفكر،بيروت،لبنان،(1415هـ-1995م).
- القاضي عبد الوهاب البغدادي، المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس،تحقيق:حميش عبد الحق،المكتبه التجارية،مصطفى أحمد الباز.
- المنبجي،جمال الدين أبو محمد علي بن أبي يحيى زكريا بن مسعود الانصاري الخزرجي(686هـ)،اللباب في الجمع بين السنة والكتاب،تحقيق محمد فضل عبد العزيز المراد،الطبعة الثانية،دار القلم،الدار الشامية،سوريا،دمشق، (1414هـ-1995م).
- ابن قدامه،أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي(620هـ)، الكافي في فقه الإمام أحمد، تحقيق محمد فارس ومسعد عبد الحميد السعدني،الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، (1414هـ-1994م).
- الزيلعي،جمال الدين أبو محمد عبدالله بن يوسف الحنفي الزيلعي(762هـ)، نصب الراية لأحاديث الهداية ومع الكتاب حاشية بغية الألمعي في تخريج الزيلعي،تحقيق محمد عوامه، مؤسسة الريان للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، (1418هـ-1997م).
- الكاساني،علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي،(587هـ)،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،(1406هـ-1986م).
- البابرتي،محمد بن محمد بن محمود أكمل الدين أبو عبدالله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي(786هـ)،العناية شرح الهداية، دار الفكر، بيروت،لبنان.
|
الهوامش:
([1]) ابو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، مادة “فهم” 4/457،دار الجيل ،1420هـ،ابن منظور الافريقي، لسان العرب، مادة “فهم”، ج12ص459،دار صادر بيروت.
([2])ابن منظور الافريقي، لسان العرب، مادة خلف”، دار صادر بيروت.
([3])علي بن ابي علي بن سالم التغلبي سيف الدين الامدي (631ه- 1233 م)، الاحكام في أصول الاحكام ، ضبطه وكتب حواشيه؛ابراهيم العجوز،منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ، ج3ص67، ، ابن الحاجب المالكي (674ه-1275م)، مختصر المنتهى الأصولي مع شرح العضد، الطبعة الثانية، دار الكتب، بيروت، لبنان، (1983م)،ج2ص171،ابو الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الاصبهاني، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، دار المدني، 1406هـ، ج2ص432،علي بن عبد الكافي السبكي(706هـ)،جمع الجوامع مع شرح المحلي،تحقبق مكتبة الكليات الأزهرية،القاهرة،الطبعة الأولى،(1981م)،ج 1ص(316-317)، ابن النجار،محمد بن أحمد بن عبد العزيز علي الفتوحي الحنبلي،شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير،تحقيق محمد الزحيلي،نزيه حماد،مركز البحث العلمي وإحياء التراث،جامعة أم القرى،مكة المكرمه،دار الفكر،دمشق،الطبعة الاخيرة،1982م،ج 3ص480.
([4])الامدي ، الاحكام في أصول الاحكام ، ج3ص63، ابن الحاجب،مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ، ج2ص171، الاصبهاني،بيان المختصر،ج 2ص432، السبكي، جمع الجوامع مع شرح المحلي، ج 1ص(316-317)، ابن النجار،شرح الكوكب المنير ج 3ص480.
([5])محمد بن علي الشوكاني (1255ه-1839 م)، ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الاصول،ص179،دار المعرفة، بيروت،لبنان، سعد الدين التفتازاني (791ه- 1388م)، حاشية التفتازاني وحاشية الشريف الجرجاني، (816ه-1413هـ) على شرح العضد (756ه-1355م) لمختصر المنتهى الاصولي لابن الحاجب المالكي (674ه-1275م)،ج2ص173، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، (1983م).
([6])الشوكاني، ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الاصول ،ص179.
([7])نقل ذلك عنه: الغزالي،محمد بن محمد(505هـ)،المستصفى من علم الأصول ومعه كتاب فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقه للإمام الحنفي ابن عبد الشكور،المطبعة الاميرية،بولاق،مصر،القاهرة،الطبعة الأولى،1985م، ج2ص191، والآمدي ، الإحكام،ج368، ،القاضي أبو يعلى ، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء (458هـ)، العدة في أصول الفقه، تحقيق د أحمد بن علي بن سير المباركي، الطبعة الثانية ، (1410 هـ – 1990 م)، ج2 ص454.
([10]) ا الآمدي، الاحكام في أصول الاحكام ،ج3ص72،.
([12])الترمذي،محمد بن عيسى بن سورة (279هـ)، الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل، وهو جامع الترمذي ،دار السلام للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، بإشراف ومراجعة صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، السعودية،الرياض، (1440هـ-1999م) ، ص1957، رقم الحديث3034، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، النسائي،ابي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان (303هـ) ،سنن النسائي الصغرى المجتبى من السنن، دار السلام للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، بإشراف ومراجعة صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، السعودية،الرياض، (1440هـ-1999م) ص2182،رقم الحديث1434.
([13] )الآمدي، الاحكام في أصول الاحكام ،ج3ص73.
([16]) ا الآمدي، الاحكام في أصول الاحكام ،ج3ص71،.
([17]) محمد بن إسماعيل البخاري (194هـ-256هـ)، صحيح البخاري المسمى( الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه)، دار السلام للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، بإشراف ومراجعة صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، السعودية، الرياض، (1440هـ-1999م)،كِتَاب فِي الِاسْتِقْرَاضِ وَأَدَاءِ الدُّيُونِ وَالْحَجْرِ وَالتَّفْلِيسِ،بَاب لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالٌ ،ص188 رقم الحيث2400.
([18])الآمدي، الاحكام في أصول الاحكام ،ج3ص70، ابن الحاجب، مختصر المنتهى،ج2ص175.
([19])البخاري، صحيح البخاري، كتَاب فِي الِاسْتِقْرَاضِ وَأَدَاءِ الدُّيُونِ وَالْحَجْرِ وَالتَّفْلِيسِ، بَاب مطل الغني ظلم ،ص 188رقم الحيث2400.
([20]) ابن الحاجب، مختصر المنتهى،ج2ص175.
([21])البخاري، صحيح البخاري، كتَاب الآداب، بَاب هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ ،ص519 رقم الحيث6154.
([22]) ا الآمدي، الاحكام في أصول الاحكام ،ج3ص71،ابن الحاجب، مختصر المنتهى،ج2ص175.
([23]) البخاري، صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم،ص114،رقم الحديث1454.
([24])الترمذي،جامع الترمذي ،كتاب الطهارة،باب اذا التقى الختانان وجب الغسل،ص1643،رقم الحديث109.
([25])مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، (261ه- 874 م)، صحيح مسلم(المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم)، دار السلام للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى ، بإشراف ومراجعة صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، السعودية-الرياض، (1440هـ-1999م) ، ص734، كتاب الحيض ،باب بيان أن الجماع كان في أول الاسلام لا يوجب الغسل، رقم الحديث775.
([26]) الآمدي، الاحكام في أصول الاحكام ،ج3ص(72-73).
([27]) الآمدي، الاحكام في أصول الاحكام ،ج3ص(72-73).
([28]) الآمدي، الاحكام في أصول الاحكام ،ج3ص(72-73).
([29])الشوكاني،ارشاد الفحول،ص179، االامدي الاحكام في أصول الاحكام ، ج3ص67، ،ابن الحاجب،مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد،ج2ص171، الاصبهاني،بيان المختصر،ج2ص432،السبكي، جمع الجوامع مع شرح المحلي،ج1ص316(-317)،ابن النجار، شرح الكوكب المنير،ج3ص480.
([31]) سورة الكهف آية (23- 24).
([34]) مسلم، صحيح مسلم، كتاب الطهار، باب النهي عن البول في الماء الراكد،ص726،رقم الحديث656.
([35])راجع في ذلك الآمدي، الاحكام في أصول الاحكام،ج3ص(72-73).
([40]) الآمدي، الاحكام في أصول الاحكام ،ج3ص(72-73).
([41]) ابن امير الحاج، التقرير والتحبير، المطبعة الاميرية،بولاق،مصر،القاهرة،دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان،الطبعة الثانية،1983م ج1ص117.
([42])راجع في ذلك:الشوكاني، ارشاد الفحول، ص(179-180)،وانظر:عبد العلي محمد بن نظام الدين، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقه،المطبعة الاميرية،بولاق،مصر،القاهرة،الطبعة الأولى،1985م ج1ص414،العضد، شرح العضد ،ج2ص174.
([45])البخاري، صحيح البخاري، كتَاب الطلاق، باب وجوب الإحداد فى عدة الوفاة وتحريمه فى غير ذلك إلا ثلاثة أيام، ص933 رقم الحيث3725.
([49])ابن نجم الحنفي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ط2، دار الكتاب الاسلامي، ج2ص234،عثمان بن علي، الزيلعي، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق ، المطبعة الاميرية الكبرى، القاهرة(1313هـ)،ج1ص268.
([50])الماوردي،ابوالحسين علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي(450هـ)، الحاوي الكبير في مذهب الإمام الشافعي وهو شرح المزني، دار الفكر، بيروت،ج3ص278، الغزالي،أبو حامد محمد بن محمد الطوسي(505هـ)، الوسيط في المذهب، تحقيق: احمد محمود ابراهيم ومحمد محمد تامر، الطبعة الاولى، دار السلام، القاهرة، (1417هـ) ،ج2ص435، الجمل، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري(1204هـ)، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل، دار الفكر، بيروت ج2 ص232.
([51])منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن ادريس البهوتي الحنبلي(1051هـ)، كشاف القناع على متن الاقناع ، دار الكتب العلمية، ج2 ص183. منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن ادريس البهوتي الحنبلي(1051هـ)، الروض المربع شرح زاد المستقنع،دار المؤيد ،مؤسسة الرسالة،ص199.
([52])الخرشي،محمد بن عبدالله المالكي أبوعبدالله(1101هـ)،شرح مختصر خليل للخرشي ، دار الفكر للطباعة، بيروت،ج2 ص148، القرطبي،أبوالوليد محمد بن احمد بن رشد(520هـ)،البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، تحقيق د. محمد حجي واخرون،ط2، دار العرب الإسلامي، بيروت ،لبنان، (1408هـ -1988 م)،ج2ص436.
([53])أبو عبدالله الحاكم محمد بن عبدالله بن محمد النسابوري المعروف بابن البيع(405هـ)، المستدرك على الصحيحين،تحقيق مصطفى عبدالقادر عطا، طـ1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،(1411هـ-1990م)، ج1 ص548.
([54])البخاري، صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم،ص114،رقم الحديث1454.خرج سابقاً هامش 22.
([55])الغزالي،الوسيط في المذهب، ج2ص435، الجمل،حاشية الجمل، ج2ص232.
([56])الزيلعي، تبين الحقائق، ج1ص268.
([57])البيهقي، أحمد بن الحسين , السنن الكبرى، ط1, مجلس دائرة المعارف ، الهند، أباد،(1344هـ)،ج4ص88.
([58])التنوخي، قاسم بن عيسى بن ناجي بن علي بن موسى الخسروجردي الخرساني أبوبكر(458هـ)، شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة، والمتن لعبدالله بن عبد الرحمن القيرواني، تحقيق احمد مزيد المزيدي،ط1 (1428هـ-2007م) ،ج1ص307.
([59])الخرشي،شرح الخرشي،ج1ص148.
([60])القرطبي،البيان والتحصيل،ج2ص436.
([61])المقصود هنا الاماء من أهل الكتاب وليس الحرائر.
([63])الرجراجي، مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها،ج4ص60.
([64])النووي،أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي(676هـ)،المجموع شرح المهذب للشيرازي،دار الفكر، ج16ص237.
([65])ابن قدامه،أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي(620هـ)، المغني ،تحقيق عبدالله بن عبد المحسن التركي و عبد الفتاح محمد الحلو، الطبعة الثالثة، عالم الكتب، الرياض،(1417هـ/1997م) ،ج9ص544،نور الدين أبي طالب عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم بن علي بن عثمان البصري الضرير(684هـ)،الواضح في شرح الخرقي،الطبعة الأولى،تحقيق عبد الملك بن عبدالله دهيش،دار خضر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، (2000م)،ح2ص612.
([67])النووي،المجموع شرح المهذب للشيرازي،ج16ص237، عبد الرحمن بن عمر الضري،الواضح في شرح الخرقي،ج2ص612،الرجراجي،مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها،تحقيق أبو الفضل الدمياطي ط1، دار ابن حزم (1428هـ- 2007م)،ج4ص60. الزيلعي ، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق،ج2ص111، ابن نجيم الحنفي،البحر الرائق شرح كنز الدقائق،3ص112.
([68])القاضي عبد الوهاب البغدادي،أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي(422هـ)، المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس،تحقيق حميش عبد الحق،المكتبة التجارية،مصطفى أحمد الباز،مكة المكرمة،ج1ص800.
([70])الزيلعي ، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق،ج2ص111.
([71])ابن نجيم ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق،ج8 ص95، علي بن سعيد الرجراجي، مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج8 ص161، زكريا محمد بن زكريا الانصاري(926هـ)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، دار الكتاب العربي، ج2 ص178، ابن قدامة،المغني ، ج6 ص584.
([72])الزيلعي، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق ،ج4ص181، ابن نجيم ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، ج8ص95.
([74])الانصاري،أسنى المطالب في شرح روض الطالب، ج2ص186.
([75])مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري(261ه- 874 م)، ، صحيح مسلم(المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم)، ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي،دار إحياء التراث العربي، بيروت،ج3 ص1197،رقم الحديث (1564).
([76])ابن قدامه،المغني،ج6ص584.
([77])مسلم ، صحيح مسلم، ج4ص2301رقم الحديث3006.
([78])مصطفى بن سعد السيوطي الرحبياني(1243هـ)،مطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى،ط2، المكتب الاسلامي، (1415هـ – 1994م)، ج3ص371، الرجراجي، مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونه،ج8ص6.
([79])علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي. سنن الدارقطني، ط1، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان (1424هــ- 2004م)، رقم الحديث 4553ج5ص415.
([80])ابن نجم الحنفي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، ج8 ص95.
([81])الزيلعي ، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق،ج4ص181.
([82])الزيلعي ، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق،ج4ص181.
([83]) ( التأبير أو التلقيح (بالإنجليزية:( ( Pollination )) في عاريات البذور ومغطاة البذور، هو عملية انتقال حبوب اللقاح التي تحتوي على خلية عروسية مذكرة إلى خلية عروسية مؤنثة تكوين بيضة مخصبة أو كائن حي جديد تابع لنفس النوع. ودراسة التلقيح هي جزء من دراسة علم النبات وعلم البيئة. وهي خطوة مهمة في عملية التكاثر الجنسي لعاريات البذور. انظر في ذلك: ويكيبيديا الموسوعة الحرة https://ar.wikipedia.org/wiki
([84]) النفراوي،أحمد بن غانم بن سالم بن مهنا الازهري المالكي(1126هـ)،الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني،دار الفكر،بيروت،لبنان،(1415هـ-1995م)،ج2ص15، القاضي عبد الوهاب البغدادي، المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس،ج1ص1012.
([85])النووي،المجموع شرح المهذب للشيرازي،ج11ص(327و336).
([86])ابن قدامه،المغني،ج6ص131.
([87])المنبجي،جمال الدين أبو محمد علي بن أبي يحيى زكريا بن مسعود الانصاري الخزرجي(686هـ)،اللباب في الجمع بين السنة والكتاب،تحقيق محمد فضل عبد العزيز المراد،الطبعة الثانية،دار القلم،الدار الشامية،سوريا،دمشق، (1414هـ-1995م)،ج2ص518.
([88])مسلم،صحيح مسلم،كتاب البيوع،باب من باع نخلا عليها ثمر،ص944،رقم الحديث3901.
([89])النووي،المجموع شرح المهذب للشيرازي،ج11ص336، القاضي عبد الوهاب البغدادي، المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس،ج1ص1012.
([90])الماوردي، الحاوي الكبير في مذهب الإمام الشافعي وهو شرح المزني،ج3ص323.
([91])ابن قدامه،أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي(620هـ)، الكافي في فقه الإمام أحمد، تحقيق محمد فارس ومسعد عبد الحميد السعدني،الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، (1414هـ-1994م)،ج2ص40.
([92])الزيلعي،جمال الدين أبو محمد عبدالله بن يوسف الحنفي الزيلعي(762هـ)، نصب الراية لأحاديث الهداية ومع الكتاب حاشية بغية الألمعي في تخريج الزيلعي،تحقيق محمد عوامه، مؤسسة الريان للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، (1418هـ-1997م)،ح4ص5.
([93])الكاساني،علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي،(587هـ)،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،(1406هـ-1986م)،ج5ص164.
([94])الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج5ص164.
([95])البخاري، صحيح البخاري، كتاب البيوع،باب إذا باع نخلا قد أبرت ،أو أرضاً مزروعة، أو بإجارة، ص171، رقم الحديث، 2204.
([96]النفراوي،الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني،ج5ص336.
([97])الماوردي، الحاوي الكبير في مذهب الإمام الشافعي وهو شرح المزني،ج11ص548، الانصاري،أسنى المطالب في شرح روض الطالب، ج3ص436.
([98])ابن قدامه،المغني، الكافي في فقه الإمام أحمد، ج3ص359.
([99])البابرتي،محمد بن محمد بن محمود أكمل الدين أبو عبدالله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي(786هـ)،العناية شرح الهداية، دار الفكر، بيروت،لبنان،ج6ص230.
Authenticity, Concept of violation, Jurisprudential rulings, Discourse guide, Principles of jurisprudence
This study has talked about an important issue of the science of jurisprudence, which was built upon the provisions of many branches and jurisprudential parts, by following the inductive approaches, and comparative analytical and this study tagged entitled: (The impact of the difference in the authenticity of the concept of violation on the difference in jurisprudence provisions) where God Almighty stated the legal provisions of the operative, and the proof of the opposite of the operative judgment (violator) is evidence of considering the restriction in the operative provision, where it dealt with the definition of the terms of the study and the statement of the authenticity of the concept of violation among scholars, and highlighting some applications The branches of jurisprudence are: the obligation of zakat on the sheep that are known, the permissibility of marrying girls in writing, the fruit that is included in the sale if the palm tree is sold or not, and the obligation to support the divorced woman and other branches of jurisprudence.
النسق البنائي لأبواب كتاب الصيام في سننأبي داود-رحمه الله
The Schematic Structure in sunan Imam Abi Dawood “Fasting Chapter
الدكتورة هدى ياسين صالح الصباغ
الأستاذ والدكتور محمد طوالبة
drhuda2018@gmail.com
تاريخ الاستلام: 2023/05/13
تاريخ القبول: 2023/11/20
يعد النَّسق البنائي الرابط المنطقي بين الأبواب بطريقة متسلسلة منتظمة؛ كما هي لبنات البناء تُبنى متوالية منتظمة متتابعة، وكذلك يكون النَّسق البنائي، فتكون الأبواب متسلسلة تسلسلاً منطقيا، وقد قامت هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي التام لكل أبواب الصيام في سنن أبي داود – رحمه الله -، ثم المنهج التحليلي والاستنباطي لتوضيح العلاقة بين أبواب الصيام. وقد اعتنى الإمام أبو داود – رحمه الله – بالنَّسق البنائي في كتابه السنن، وأسهم ذلك في الكشف عن مذهب الإمام أبي داود – رحمه الله – في بعض المسائل الفقهية، وتوضيح المذاهب الفقهية، وبيان مواضع الاتفاق والاختلاف بين العلماء، وتوضيح مذهبه في مختلف الحديث، وفي ذلك فهم عميق لعلم الحديث وفقهه، ومذاهب علماء الحديث، وكيفية النظم في كتب علماء الحديث.
وخلُص البحث إلى نتائج عدة أهمها:
-أن النَّسق البنائي هو النظام الذي يضم أجزاء المكون بعضها إلى بعض على جهة الثبوت بروابط منتظمة مطردة، تسهم في فهم دلالات النصوص، ومعرفة دورها الوظيفي.
-أن علاقة النَّسق البنائي بالمناسبة؛ فيها تشابه من حيث الربط بين مكونات متعددة، أما المناسبة فتكون بين أمرين، وذلك لبيان العلاقة بينهما من حيث انتظامها في السياق والسباق.
-اعتنى الإمام أبو داود – رحمه الله – بالنَّسق البنائي لأبواب كتاب الصوم في سننه من حيث أن المناسبات بين الأبواب تظهر بشكل واضح بين كل باب والباب الذي يليه، وفي ذلك اتصال بديع بين كل باب والذي يليه كما اتصل بما سبقه من الأبواب؛ وفق ننسق بديع في ترتيب الأبواب.
أبو داود، النَّسق البنائي، أبواب الصيام.
مقدمة:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد – صلى الله عليه وسلم -، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن من نعم الله علينا أن جعلنا الله من هذه الأمة المرحومة؛ أهل القرآن الذي تولى الله – عز وجل – حفظه قال الله تعالى: {إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ}[1]، والسنة النبوية الشريفة التي قيَّض الله لها من العلماء مَنْ اعتنى بها حفظاً وضبطاً وتلقيناً وتدوينا وأداءً، وقد تطورت مناهج التدوين من الصحف والأجزاء إلى الجوامع والموطآت والمسانيد، إلى أن وصلت أوجها في القرن الثالث الهجري، الذي يعد العصر الذهبي في التصنيف للعلوم ومنها علوم الحديث.
وممّن نَبَغ في علوم الحديث الإمام أبو داود – رحمه الله – وهو من أبرز المحدِّثين النقّاد الذين برزوا بتصنيفاتهم العظيمة؛ وأشهرها كتابه المعروف بالسُّنن، وقد عُنِي الإمام أبو داود – رحمه الله – بأحاديث الأحكام فقال: “هذه الأحاديث أحاديث السنن كلها في الأحكام“[2].
وفي هذا البحث يحاول الباحثان الكشف عن نسق ترتيب الأبواب من خلال دراسة تراجم أبواب كتاب الصيام.
مشكلة الدراسة:
تكمن مشكلة الدراسة في الإجابة عن السؤال الرُئيس الآتي:
ما مدى تحقق عناصر النَّسق البنائي في كتاب الصوم في سنن أبي داود – رحمه الله -؟
ويتفرع عن هذا السؤال الأسئلة الآتية:
- 1. ما مفهوم النَّسق البنائي؟
- 2. ما علاقة النَّسق البنائي بالمناسبة؟
- 3. ما النَّسق البنائي لأبواب كتاب الصوم في سنن أبي داود – رحمه الله -؟
أهداف الدراسة:
- 1. توضيح مفهوم النَّسق البنائي.
- 2. توضيح علاقة النَّسق البنائي بالمناسبة.
- 3. إبراز معالم النَّسق البنائي لأبواب كتاب الصوم في سنن أبي داود – رحمه الله -.
أهمية الدراسة:
- 1. تبين أن علماء الحديث قد صنفوا كتبهم على منهج واضح متناسق، وذلك بما يخدم السنة النبوية المشرفة.
2.تُفصح عن مدى اهتمام علماء الحديث وعلى رأسهم أبي داود – رحمه الله – السِجِسْتاني بأحاديث الأحكام وفقهها واستنباط أحكامها.
3.تبين مدى اطراد النَّسق البنائي لتراجم أبواب سنن أبي داود – رحمه الله –.
4.ويُضاف إلى ذلك أنّ الدراسات التي تُعنى في بيان النَّسق البنائي في كتب السنة تعد قليلة نوعاً ما؛ فجاءت هذه الدراسة استكمالاً لما بدأ به غيرنا في تناول عناصر هذا العلم وربطه بعلم الحديث.
الدراسات السابقة:
- بعد البحث والتفتيش في الكتب ذات العلاقة وقف الباحثان على كتب ودراسات تتناول النَّسق البنائي في كتب الحديث بشكل عام، أما فيما يخص سنن أبي داود – رحمه الله – فلا يوجد إلا دراسة واحدة للدكتور عبد الله مهيدات وعنوانها “النَّسق البنائي في كتاب الطهارة بين سنن أبي داود – رحمه الله – وجامع الترمذي”، البحث المنشور للدكتور مهيدات[3].
وقد هدفت الدراسة إلى: الكشف عن النَّسق البنائي في كتاب الطهارة عند أبي داود – رحمه الله – والترمذي؛ والمقارنة بينهما.
- ورقة بحثية بعنوان “مراعاة السياق وأثره في فهم السنة النبوية”، للأستاذ الدكتور فاروق حمادة، صادرة عن مجلة الإحياء، عدد: 26.
وقد هدفت الدراسة إلى: بيان أثر السياق في فهم السنة النبوية، من خلال دراسة للأحاديث النبوية، وتوضيح أثر السياق وأنه أمر أساس لفهم السنة النبوية.
وقد قسَّمها إلى: ستة عناوين بعد أن قدّم لها، العنوان الأول: السياق هو الذي يحدد الفهم الصحيح والحكم الواضح الصريح، العنوان الثاني: إذا تعددت الرؤى، العنوان الثالث: مراعاة السياق يؤدي إلى معرفة مخارج الحديث هل هو فرد أو عزيز أو مشهور أو متواتر، العنوان الرابع: استطاع المحدثون بيان الأسباب وسياق الأحاديث بملابساتها وظروفها تحديد الأحاديث المنسوخة، العنوان الخامس: معرفة سياق الحديث وملابسات وروده تحدد تاريخ النص وبذلك يتبين المتأخر ويجري الحكم به، العنوان السادس: معرفة سبب الحديث وسياق وروده تحدد الموقع والجهة التي ينصرف لها سبب الورود.
وخلصت الدراسة إلى: أن مراعاة السياق أمر أساس في فهم السنة النبوية، حتى لا تبدو السنة متناقضة أو متعارضة.
التقاطع بين الورقة البحثية مع دراسة الأطروحة: أن السياق يأتي مقاربا لمعنى النسق البنائي، من حيث التناسق في تجميع وترتيب الأحاديث وتنسيقها في موضوع واحد يحتوي على أبواب على نسق واحد ونظم متسلسل بديع.
الاختلاف بين الورقة البحثية ودراسة الأطروحة: أن الورقة البحثية تحدثت بشكل مقتضب عن السياق وعام في السنة النبوية الشريفة، بينما تخصصت الأطروحة في سنن الإمام أبي داود على وجه الخصوص.
- بحث بعنوان “خطة السياق، ومحاولة تطبيقها على النص الحديثي” للدكتور محمد خروبات، سلسلة الإسلام والسياق المعاصر، الرابطة المحمدية للعلماء، مراكش، قُدم البحث للندوة التي أقيمت الندوة عام 1428هـ الموافق 2007م، الرباط، المغرب.
وقد هدف البحث إلى: بيان حقيقة السياق وأهميته في التعامل مع النصوص بصفة عامّة والنص الحديثي بصفة خاصة، وأهمية السياق في ضبط الحديث من جهة الصحة والضعف، وضبط قواعد وآليات التعامل مع النص، وسياق الأسانيد والألفاظ والمعاني، وأن الثقافة الإسلامية بحاجة ماسة إلى منهجية السياق في التعامل مع نصوص السنة النبوية.
وقد قسَّمه إلى: ستة مباحث، المبحث الأول: محاولة تأصيلية لمفهوم السياق في اللغة والاصطلاح، المبحث الثاني: سلطات النص الستة، السلطة الصورية والفاعلة والمادية والغائية والمنهجية والاعتبارية، المبحث الثالث: منهجية السياق وتطبيقاتها على النصوص بصفة عامة والنص الشرعي منه بصفة خاصة، المبحث الرابع: بيان خطة السياق والنص اللغوي من جهة الربط والنظام النحوي وما يتعلق به من السياق المقامي والمقالي، المبحث الخامس: تنبيه مطبقي خطة السياق على النص الحديثي إلى مجموعة من المحاذير المعرفية، والمبحث السادس: خطة السياق والنص الحديثي.
وخلصت الدراسة إلى: التأكيد على أن الثقافة الإسلامية بحاجة ماسّة إلى منهجية السياق في التعامل مع نصوص السنة النبوية.
التقاطع بين البحث ودراسة الأطروحة: أن البحث يتناول السياق بصورة عامّة والسياق يقارب النسق البنائي للناحية النظرية والعملية.
الاختلاف بين البحث ودراسة الأطروحة: أن البحث تناول منهجية السياق وتطبيقاته على النصوص بصفة عامّة والنص الشرعي منه بصفة خاصة، ودعت إلى اعتبار السياق في الحديث النبوي الشريف، بينما تخصصت الأطروحة في بين منهج الإمام أبي داود في سننه على وجه الخصوص.
- بحث بعنوان “ضوابط فهم السنة عند الإمام الشافعي” للدكتور نادر نمر وادي، قسم الحديث الشريف، جامعة الأقصى، غزة، ط1، 1441هـ – 2020م، مقدم لمؤتمر الإمام الشافعي، 1433هـ -2012م.
وقد هدف البحث إلى: توضيح للفهم الصحيح للسنة النبوية من خلال الضوابط التي بيّنها الإمام الشافعي عند النظر إلى النصوص الشرعية، كونه أول من صنّف في الضوابط والقواعد في النصوص الشرعية.
وقد قسَّمه إلى: مبحثين المبحث الأول: الإمام الشافعي وفهم السنة النبوية، المبحث الثاني: ضوابط السنة عند الإمام الشافعي، وقد ذكر إثني عشر ضابطا، والضابط الخامس تحدث فيه عن مراعاة السياق.
وخلص البحث إلى: ضرورة الفهم الصحيح للسنة النبوية، والعناية بالحديث من حيث التثبت من صحة الحديث وفهمه على ضوء فهم السلف، ومقاصد الشريعة، ومراعاة السياق الذي جاء فيه الحديث، وغير ذلك من ضوابط فهم السنة النبوية، وقد أوضح الإمام الشافعي أن للسياق أهمية كبيرة في فهم السنة؛ وقد نبه على أهمية هذا الضابط في فهمه للسنة، أو للنصوص الشرعية عموما، فقد بوّب الشافعي بقوله: “باب الصنف الذي يبين سياقه معناه”، وذلك نظرا لأهمية السياق في فهم السنة النبوية الشريفة.
التقاطع بين البحث ودراسة الأطروحة: أن البحث يتناول الضوابط لفهم السنة النبوية عند الإمام الشافعي، ومن هذه الضوابط مراعاة السياق وهذا يقارب الفهم للنسق البنائي في فهم السنة من خلال دراسة الحديث النبوي.
الاختلاف بين البحث ودراسة الأطروحة: أن في البحث بيان للفهم الصحيح للسنة النبوية من خلال الضوابط التي بيّنها الإمام الشافعي في فهم النصوص الشرعية، وكان السياق من الضوابط الهامّة في النصوص الشرعية للحديث النبوي الشريف، بينما تناولت الأطروحة النسق البنائي في سنن الإمام أبي داود كأنموذج في بيان منهجه.
- رسالة دكتوراه “السياق وأثره في فهم الحديث النبوي دراسة نظرية تطبيقية” للدكتور محمد عبد الله السوالمة إشراف الدكتور محمد عيد محمود الصاحب، رسالة دكتوراه، الجامعة الأردنية، كلية الدراسات العليا، 2013م. وقد هدفت الدراسة إلى: بيان أهمية السياق في فهم نصوص الشريعة، وتأكيد ذلك بالأدلة الموضحة له. ومن الناحية التطبيقية توضيح الأوجه التي وظف فيها العلماء السياق في فقه السنة النبوية، وإبراز أثر ذلك في اختلاف الفقهاء.
وقد قسَّمها إلى: خمسة فصول، الفصل الأول: مفهوم السياق وأقسامه وأهميته، الفصل الثاني: الاعتبار بالسياق وإعماله وضوابط الأخذ به، الفصل الثالث: أثر السياق في فهم نصوص السنة وتحليلها وتوجيه معانيها، الفصل الرابع: أثر دلالة السياق في شروح كتب الحديث، الفصل الخامس: تطبيق أثر السياق في كتب الشروح الحديثية.
وخلصت الدراسة إلى: بيان أهمية السياق في فهم نصوص الشريعة، وأثر ذلك الفهم للأحاديث النبوية ودلالة السياق على معاني الحديث النبوي الشريف في شروح الحديث.
التقاطع بين البحث ودراسة الأطروحة: الأطروحة هدفت لبيان أهمية السياق في فهم نصوص الشريعة، والأدلة على ذلك في النصوص الشرعية، والسياق من خلال الفهم العميق لمعانيه يأتي بمعنى النسق، وقد أوضح الدكتور السوالمة عند الحديث عن المعنى اللغوي للسياق وأنّ “من معانيه التتابع والتسلسل والانتظام في سلك واحد ومنه سياق الكلام وتتابعه وانتظامه ودقة نظمه”[4]، وبهذا المعنى هو موافق لمعنى النسق البنائي، كما تناولته الدراسة الخاصة بالنسق البنائي في سنن الإمام أبي داود.
الاختلاف بين الدراسة ودراسة الأطروحة: أن في الدراسة بيان أهمية السياق في فهم نصوص الشريعة، واستكمال الدراسة للبيان بالتفصيل في الناحية التطبيقية، بينما تخصصت الأطروحة في النسق البنائي في سنن الإمام أبي داود في كتاب الصوم لبيان منهجه.
- رسالة ماجستير بعنوان “أثر السياق في توجيه شرح الأحاديث عند ابن حجر في كتابه فتح الباري” للباحث أحمد مصطفى أحمد الأسطل، بإشراف الدكتور فوزي إبراهيم أبو فياض، كلية الآداب، الجامعة الإسلامية، غزة، 1432هـ – 2011م.
وقد هدفت الدراسة إلى: الكشف عن مدى وعي الحافظ ابن حجر لأهمية السياق في توجيه المعنى في الأحاديث الشريفة؛ وقد استعمل الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري عند شـرحه للأحاديـث الــسياق اللغــوي، وســياق الحــال.
وقد قسَّمها إلى: أربعة فصول، الفصل الأول: مفهوم السياق والمعنى، الفصل الثاني: أثر السياق في توجيه دلالة العلاقات التركيبية، الفصل الثالث: أثر السياق في توجيه بعض الظواهر اللغوية، الفصل الرابع: أثر سياق الحال في توجيه الدلالة عند ابن حجر.
وخلصت الدراسة إلى: توضيح الأهمية للسياق في شرح الأحاديث النبوية، وتفطن الحافظ ابن حجر لذلك، واستعماله للسياق في شرح الأحاديث.
التقاطع بين البحث ودراسة الأطروحة: تحدثت الدراسة عن السياق في فتح الباري عند الحافظ ابن حجر، والتشابه من حيث موضوع السياق في شرح السنة النبوية الشريفة في فتح الباري، وهو أمر مشترك حيث أن السياق يعد مشابها إلى حد كبير للنسق البنائي.
الاختلاف بين الدراسة ودراسة الأطروحة: أن في الدراسة بيان لمنهج الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري موضحا لأهمية السياق في تفسير الأحاديث، بينما تناولت الدراسة النسق البنائي في سنن الإمام أبي داود في كتاب الصوم خاصة لبيان منهجه.
- رسالة دكتوراه بعنوان “السياق وأثره في توجيه المعنى في شرح النووي على صحيح الإمام مسلم، دراسة وصفية تحليلية” للدكتور صلاح حسين سعدون البياتي، جامعة العلوم العلمية الإسلامية، كلية الدراسات العليا، عمان، 2017م.
وقد هدفت الدراسة إلى: تناولت الدراسة في هذه الرسالة أصل عظيم من أصول اللغة ألا وهي نظرية السياق، وتطبيقه من خلال شرح النووي على صحيح الإمام مسلم.
وقد قسَّمها إلى: ثلاثة فصول، الفصل الأول: سيرة الإمام النووي، ورحلته لطلب العلم، وآثاره فيها، الفصل الثاني: السياق عند علماء العرب، وأصوله واهتمامهم به، الفصل الثالث: السياق عند علماء اللغة المحدثين، أثر السياق في توجيه دلالة العلاقات التركيبية في شرح النووي على مسلم.
وخلصت الدراسة إلى: التأكيد على الدور العظيم للسياق في توجيه المعاني في النصوص الشرعية في تطبيق نظرية السياق على صحيح مسلم.
التقاطع بين البحث ودراسة الأطروحة: تحدثت الدراسة عن السياق في صحيح مسلم بشرح النووي، والتشابه من حيث بيان دور السياق في توجيه الحديث في شرح النووي على مسلم، والسياق هو الأمر المقارب للنسق البنائي.
الاختلاف بين الدراسة ودراسة الأطروحة: أن في الدراسة بيان لمنهج النووي في شرحه لصحيح مسلم نظرا لدور السياق في فهم الحديث وتوجيه معناه، وقد اعتنى بالناحية اللغوية في ذلك، بينما تناولت الدراسة النسق البنائي في سنن الإمام أبي داود في كتاب الصوم بالاعتماد على النصوص الشرعية لعلماء شروح الحديث بشكل أساس.
- رسالة دكتوراه “أثر السياق في توجيه المعنى دراسة تطبيقية في صحيح مسلم” للدكتوره مريم وصل الله صامل الرحيلي، السعودية، وزارة التعليم العالي، جامعة طيبة، قسم الآداب، 1431هـ – 2010م.
وقد هدفت الدراسة إلى: توضيح الدور العظيم للسياق في فهم المقصود من الحديث والكشف عن معناه وتوجيه المعنى للحديث النبوي، وعناية العلماء بالسياق وتوظيفه في فهم معاني الألفاظ في النص، وتطبيق ذلك على نصوص صحيح مسلم.
وقد قسّمتها إلى: التمهيد ويقسم إلى ثلاثة مباحث، المبحث الأول: السياق، المبحث الثاني: المعنى، المبحث الثالث: صحيح مسلم، والفصل الأول: أثر السياق في المستوى الصوتي في صحيح مسلم، ويقسم إلى ثلاثة مباحث، المبحث الأول: أثر السياق في اختلاف الأصوات، المبحث الثاني أثر السياق في المشترك اللفظي، المبحث الثالث أثر السياق في الأضداد.
وخلصت الدراسة إلى: إظهار الأهمية للسياق في فهم الحديث وتوضيح معناه، واستكمال الدراسة ببيان ذلك من خلال التمثيل بنصوص صحيح مسلم، وإبراز العلاقة القوية بين اللغة والأحكام الشرعية.
التقاطع بين الدراسة ودراسة الأطروحة: تناولت الدراسة السياق في صحيح مسلم، والتشابه من حيث موضوع السياق في شرح السنة النبوية الشريفة في صحيح مسلم، وما يتعلق بالسياق يعد مما فيه مقاربة كبيرة للنسق البنائي.
الاختلاف بين الدراسة ودراسة الأطروحة: أن في الدراسة بيان للأثر العظيم للسياق في شرح السنة النبوية الشريفة في صحيح مسلم موضحا والأهمية للسياق في توجيه الأحاديث، بينما تناولت الدراسة النسق البنائي في سنن الإمام أبي داود في كتاب الصوم خاصة لبيان منهجه.
- بحث بعنوان “من ضوابط فهم السنة النبوية: جمع الروايات في الموضوع الواحد وفقهها”، للباحث أحمد بن محمد فكير، كلية الآداب، أكادير، المغرب.
وقد هدف البحث إلى: توضيح أن من ضوابط فهم السنة النبوية فهما صحيحا جمع الروايات الواردة في الموضوع الواحد، ومقابلة بعضها ببعض، وإعمال النظر فيها، ومن الفوائد الهامة التي نكتسبها من إعمال هذه القاعدة معرفة سبب ورود الحديث، وتعليل الحكم الذي تضمنه، وغير ذلك من الأمور الهامة؛ ويُعد النظر الصائب هو الذي ينظر في جميع الأدلة؛ وهذا منهج علمي دقيق يؤدي إلى الفهم الصحيح، ويساعد في فهم النصوص بأسبابها ومقاصدها. وإعمال هذا المنهج الكلي في الاستنباط من النصوص يستلزم التتبع والروية وملكة فقهية واسعة، وهذا كان ديدنَ الفقهاء المحققين.
وقد قسّمه إلى: أربعة مباحث، المبحث الأول: جهود المحدثين في فهم السنة النبوية، المبحث الثاني: قاعدة جمع الروايات في الموضوع الواحد، المبحث الثالث: أمثلـــة لتطبيقات هذه القاعدة، المبحث الرابع: فوائد جمع الروايات في الموضوع الواحد.
وخلص البحث إلى: أن العناية بقاعدة جمع الروايات في الموضوع الواحد، هي التي توصل للفهم الصحيح للحديث النبوي الشريف، وهذا هو المنهج الصحيح للدراسة الحديثية السليمة.
التقاطع بين البحث ودراسة الأطروحة: تناول البحث قضية جزئية في الفهم الصحيح للحديث النبوي وهي جمع الروايات الواردة في الموضوع الواحد، وهذا المنهج العلمي الدقيق يقارب النسق البنائي في ضرورة إعمال النسق في النظر والتأمل عند جمع أحاديث الباب والنظر في النسق الذي تسير عليه في ترتيبها حسب نسق واحد.
الاختلاف بين البحث ودراسة الأطروحة: تناول البحث قضية جزئية لها علاقة بالنسق البنائي جمع الروايات الواردة في الموضوع الواحد حيث أن النسق البنائي يعتمدها عند التعمق في فهم السنة النبوية الشريفة، بينما تناولت الدراسة النسق البنائي عموما في سنن الإمام أبي داود في كتاب الصوم خاصة لبيان منهجه.
- بحث بعنوان “السياق وجمع الروايات وأسباب الورود وأثرها في فهم الحديث“ للدكتور عبد الله حامد سمبو، جامعة أم القرى، قسم الكتاب والسنة، مستلة من حولية كلية أصول الدين والدعوة، الأزهر، المنوفية، عدد: 33، عام 1435هــ – 2014م.
وقد هدف البحث إلى: الدعوة إلى الفهم السليم في التعامل مع النصوص انطلاقا وانسجاما مع المنهجيات والقواعد الأصولية التي وضعها العلماء، والعناية بمدلولات النص وفهمه فهما صحيحا.
وقد قسّمه إلى: أربعة مباحث، المبحث الأول: فهم الحديث في ضوء السياق وسبب الورود، المبحث الثاني: سبر الحديث وجمع الروايات الواردة في الحديث الواحد، المبحث الثالث: الجمع أو الترجيح بين مختلف الحديث، المبحث الرابع: مظاهر سوء الفهم للسنة النبوية.
وخلص البحث إلى: إلى أن الفهم السليم للنصوص ينسجم مع المناهج الموضوعة من العلماء، لكشف مدلولات النص وفهمه فهما صحيحا.
التقاطع بين البحث ودراسة الأطروحة: تناول البحث قضية السياق وجمع الروايات وأسباب الورود وأثرها في فهم الحديث؛ وهذه الأمور من مقتضيات الفهم الصحيح للحديث النبوي لبيان النسق الذي يبنى عليه الحديث النبوي في النسق البنائي للحديث.
الاختلاف بين البحث ودراسة الأطروحة: تناول البحث قضية السياق وجمع الروايات وأسباب الورود وأثرها في فهم الحديث؛ وكلن الطرح للنصوص الحديثية بشكل عام، بينما تناولت الدراسة النسق البنائي في سنن الإمام أبي داود في كتاب الصوم.
منهج الدراسة:
تقوم الدراسة على المنهج الاستقرائي التام لجميع أبواب كتاب الصوم في سنن الإمام أبي داود – رحمه الله – السِجِسْتاني، وتحليل العلاقة بين أبواب كتاب الصوم واستنباط النَّسق البنائي للأبواب.
خطة البحث:
اشتمل البحث على مقدمة، وخمسة مباحث، وخاتمة. وهي كما يلي:
المقدمة: واحتوت على مشكلة الدراسة، وأهمية الدراسة، وأهداف الدراسة، والدراسات السابقة، والمنهج المتبع من الباحثة في دراستها.
المبحث الأول: تعريف النَّسق البنائي لغة واصطلاحا وعلاقته بالمناسبة، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف النَّسق البنائي لغة واصطلاحا.
المطلب الثاني: علاقة النَّسق البنائي بالمناسبة.
المبحث الثاني: النَّسق البنائي لأبواب ثبوت رمضان والسُّحُور، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: النَّسق البنائي لأبواب ثبوت رمضان.
المطلب الثاني: النَّسق البنائي لأبواب السُّحُور.
المبحث الثالث: النَّسق البنائي لأبواب أحكام فطر الصائم، وفيه مطلبان.
المطلب الأول: النَّسق البنائي لأبواب وقت الفطر.
المطلب الثاني: النَّسق البنائي لأبواب ما يُفطِّر الصائم.
المبحث الرابع: النَّسق البنائي لأبواب أحكام صوم المسافر، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: النَّسق البنائي لاختيار الصوم أو الفطر للمسافر.
المطلب الثاني: النَّسق البنائي لوقت ومسافة الفطر للمسافر.
المبحث الخامس: النَّسق البنائي لأبواب صوم النافلة والاعتكاف، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: النَّسق البنائي لأبواب كراهية صوم النافلة.
المطلب الثاني: النَّسق البنائي لأبواب استحباب صوم النافلة.
المطلب الثالث: النَّسق البنائي لأبواب الاعتكاف.
وأخيرًا أسالُ الله تعالى أن يحظى هذا العمل بالرضا والقبول، وأن يكون خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفعَ به طلبة العلم، والله تعالى ولي التوفيق.
المبحث الأول: تعريف النَّسق البنائي لغة واصطلاحا وعلاقته بالمناسبة، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف النَّسق البنائي لغة واصطلاحا.
ويدرس هذا المطلب مفهوم النَّسق في اللغة والاصطلاح
النَّسق لغة:
المصدر للفعل نَسَق، ويحتمل خمسة معاني وهي:
التنظيم، والعطف، والمساواة، والتتابع، والانضمام والاقتران[5].
البنائي لغة:
بني: بَنَى البنّاءُ، والبَنْيُ: نَقيضُ الهَدْم[6]، والبناء يأتي بمعنيين وهما:
النَّسق البنائي:
وبعد التعرف على المعنى اللغوي لمفردات المركب اللغوي نتوصل لمعنى النَّسق البنائي، ونمهد لذلك بمعرفة مفهوم مفردات النسق البنائي.
يُعد جوهر النسق هو: “العلاقات القائمة بين العناصر، على اعتبار أن الكل ليس إلا الناتج المترتب على تلك العلاقات أو التآلفات مع ملاحظة أن قانون هذه العلاقات ليس إلا قانون النسق نفسه”[9].
وذلك يعني أن النسق يعتمد على ترابط العناصر المكونة له، من خلال العلاقات التي تربط بين تلك العناصر.
“والبناء من البنية وهي مجموعة من العلاقات بين عناصر مختلفة، وهذا يسمى النظام؛ والبنية تتميز بالعلاقات والتنظيم بين العناصر المختلفة”[10].
“تُبين النظرية البنائية علاقة البُنى من خلال النظام الذي تنتمي إليه، ويقوم النسق البنائي على التركيز والاهتمام لا على العنصر الواحد فحسب، ولا على الكل المفروض؛ بل إن ما يهمه هو ملاحظة العلاقات المتداخلة التي تربط بين العناصر، ثم عملية تشكيل الكل التي لا تتوقف من خلال هذه العلاقات”[11].
وتؤسس النظرية البنائية للإبانة عن طرق انتظام العناصر في إطار نسق عام يكشف كل عنصر ودوره الوظيفي، وهذه النظرية تبين أهمية الانتقال من الجزء إلى الكل في تكوين النسق[12].
وتقوم البنائية في النص على بُنية محددة ونسق أو مجموعة أنساق وأنظمـة محـددة؛ فالنص واحد بأبنيته وأنساقه[13].
والنَّسق هو الذي يكشف عن سر وضع الألفاظ ونسبة بعضها إلى بعض وهو الذي اختاره الزمخشري وبني عليه الأساس[14].
وتدل النَّسقية، في اللغة، على التنظيم، والترابط، والتماسك، والتسلسل، وتتابع الأفكار، وانتظامها في نسيج نصي موحد موضوعيا وعضويا[15].
“والبناء من البُنية وهي مجموعة من العلاقات بين عناصر مختلفة، وهذا يسمى النظام؛ والبُنية تتميز بالعلاقات والتنظيم بين العناصر المختلفة”[16].
وقد عّرفه الإمام السيوطي في معرض حديثه عن النَّسق في القرآن الكريم بقوله:
النَّسق في القرآن: “ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني علم عظيم”[17].
والنَّسق: “هو نظام مكون من أجزاء، وتضبطه آليات تحكم[18]“.
والتنسيق: “هو ترتيب أجـزاءٍ شـتى وتنظيمها من أجل الحصـول علـى كـل متماسك مترابط، أو تنظيم الأعمال في مؤسسة أو مشروع أو إدارة، على نحٍو يكفل حسن سيرها، ويحقق الانسجام بين عناصرها[19]“.
قال الغدامي: النَّسق مرادف للبنية أو النظام[20].
وقال الرافعي: ” إن سر الإعجاز هو في النظم، وأن لهذا النظم ما بعده؛ وقد علمت أن جهات النظم ثلاث: في الحروف، والكلمات، والجمل “[21].
وعرّفه الدكتور عامر محمد العزايزة: “هو ترابط الكل المكون من أجزاء بترتيب وتنظيم معين[22]“
النَّسق البنائي اصطلاحا:
المعنى الاصطلاحي: وقد عرّفه الدكتور عبد الله مهيدات بأنه: “النظام الذي يضم أجزاء المكون بعضها إلى بعض على جهة الثبوت بروابط منتظمة مطردة، تسهم في فهم دلالات النصوص، ومعرفة دورها الوظيفي”[23].
المطلب الثاني: علاقة النَّسق البنائي بالمناسبة.
وحتى نجد العلاقة بين النَّسق البنائي والمناسبة؛ لا بد من النظر في التعريف لكلٍ منهما.
قال ابن فارس: “نَسَبَ: النُّونُ وَالسِّينُ وَالْبَاءُ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ قِيَاسُهَا اتِّصَالُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ”[24].
والمُناسَبةُ: المُشَاكَلَةُ، ويقالُ: بَين الشَّيْئَين مُنَاسَبَةٌ وتَنَاسُبٌ: أَي مُشَاكَلَةٌ وتَشَاكُلٌ[25]، وَيُقَال ناسب الْأَمر أَو الشَّيْء فلَانا لاءمه وَوَافَقَ مزاجه[26].
التناسب في الاصطلاح:
عرَّف البقاعي مناسبات القرآن قال: “علم مناسبات القرآن علم تُعرف منه علل ترتيب أجزائه”[27]. وقال مسلم في تعريف المناسبة: “هي الرابطة بين شيئين بأي وجه من الوجوه”[28]
وفي بيان أهمية المناسبة ومكان وجودها قال الإمام الزركشي: “إيقاع المناسبة في مقاطع الفواصل مؤثر في اعتدال نسق الكلام وحسن موقعه من النفس تأثيرا عظيما ولذلك خرج عن نظم الكلام لأجلها في مواضع”[29].
والإمام الزركشي يتحدث عن المناسبة بين الفواصل في كتاب الله؛ والمناسبة بين الفواصل في السورة الواحدة والمناسبة بين السور القرآنية.
وقال السيوطي: “علم المناسبة علم شريف ودقيق؛ وممن أكثر فيه الإمام فخر الدين وقال في تفسيره: أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط”[30].
أما علاقة النسق بالمناسبة فقد عبَّر الإمام البقاعي عنها بقوله: ناسب؛ وفي ذلك إشارة إلى الربط بين السورتين ببيان التناسق بينهما[31]، وبهذا تم بيان علاقة النسق بين السور في القرآن الكريم.
والتعبير بالمناسبة بين العلماء هو ما يقصدون به التناسق بين الآيات في القرآن الكريم، وبين السور في ترتيبها وتناسقها واتساقها، وكذا بين أبواب الحديث في السنة النبوية الشريفة.
وبناءً على ذلك نستنتج أن التناسب هو رابط او علاقة بين مكونين؛ وهذا هو الشبه بين التناسب والنسق من حيث أن كلاً منهما يعد رابط او علاقة للربط بين المكونات للبناء.
أما الفرق بينهما أن المناسبة هي أداة الربط بين مكونين أو شيئين، أما النسق فهو أداة ربط بين أمور متعددة.
وعليه فالنتيجة هي: وبعد تعريف النَّسق والمناسبة نرى أن النَّسق والمناسبة بينهما تشابه من حيث الربط بين مكونات متعددة في نظم واحد متناسق بين المكونات.
أما الفرق بين النَّسق والمناسبة أن النَّسق يكون بين مكونات متعددة تنتظم في نسق واحد، أما المناسبة فتكون بين أمرين، وذلك لبيان العلاقة بينهما من حيث انتظامها في السياق والسباق[32].
والمثال الذي يوضح ذلك من صنيع الإمام العيني عند إيراده باب الجهاد من الإيمان بعد باب قيام ليلة القدر من الإيمان؛ ووجه المناسبة بين البابين هو أن قيام ليلة القدر يحتاج إلى مجاهدة النفس، فكذلك المجاهد يجتهد أن ينال درجة الشهداء، وهذا هو وجه النسق بين البابين؛ والمناسبة بين هذه الأبواب كلها هي اشتراكها في كونها من خصال الإيمان[33]. فعندما كان الحديث عن علاقة بين مكونين استعمل لفظ المناسبة وعندما انتقل الحديث عن علاقة بين متعدد استعمل لفظ التناسق، وهذا هو الشائع في استعمال النسق[34].
المبحث الثاني: النَّسق البنائي لأبواب ثبوت رمضان والسُّحُور، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: النَّسق البنائي لأبواب ثبوت رمضان.
سيقوم الباحثان في هذا المطلب بالكشف عن النَّسق البنائي لأبواب الصوم من خلال معرفة مناسبات الأبواب، وحيث توجد المناسبات بين الأبواب يتبين النَّسق البنائي بينها.
الباب الأول: باب مبدأ فرض الصِّيام[35].
والمقصود من مبدأ فرض الصيام بيان أول ما فُرض منه[36].
وقد جعل الإمام أبو داود – رحمه الله – كتاب الصِّيام تالياً لكتاب الطلاق؛ “وتعقيب المُصنِّف بكتاب الصِّيام بعد كتاب الطلاق، ووجه ذلك أن الطلاق فيه تسريح للزوجة مما يمنع الزوج من قضاء حاجته التي اعتاد على قضائها كلما أراد وهذا يحتاج إلى مصابرة وأفضل معين على ذلك الصوم لأنه قاطع للشهوة الحديث النبوي[37]، والأصل يقتضي أن يذكر بعد النكاح للمناسبة بين النكاح والصِّيام؛ لأجل أن الصوم تقييد للنفس كما أن النكاح تقييد للمرأة، وكذلك كما أن النكاح قاطع للشهوة كذلك الصِّيام قاطع لها، كما قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: “فإنه له وجاء”، ولكن لما كان الطلاق أنسب للنكاح، لأنه من توابعه ولواحقه ذكره بعده، ثم ذكر الصِّيام”[38]. ومناسبة الباب أنه جاء كتقدمة لفرض الصوم علينا، وذلك أن الله تبارك وتعالى قد بيَّن فيه الخط التاريخي للصيام الذي بدأ بالأمم السابقة لنا؛ وأتمَّه الله بأمرنا بالصِّيام كما أمر مَنْ كان قبلنا.
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيام كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ}[39].
الباب الثاني: باب نسخ قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}[40].
ومناسبته للباب السابق بيان التدرج في فرض الصِّيام، بعد أن ذكر صيام الأمم السابقة، بيَّن أن الصوم كان في ابتداء الأمر على التخيير بين الصوم والفدية، حتى جاءت الآية التي تلتها، فنسختها وأمرت بالصوم على سبيل الوجوب؛ وفي النسخ رحمة بالأمة ورفع للحرج.
الباب الثالث: باب من قال: هي مثبتة للشيخ والحُبْلى.
أي: الفدية، وأُثبتت الفدية للحبلى والمرضع أي أثبتت[41] آية {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} لهما، ونُسخت في الباقي[42]. ومناسبة الباب للباب السابق أن هذا الباب خصَّص النص العام في الباب السابق في قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ} بأفراد مخصوصين وهم الشيخ والحُبْلى؛ فتبقى الفدية في حق الشيخ والحُبْلى، وفي ذلك تمام بيان وتوضيح لمن وجب عليهم الصيام.
الباب الرابع: باب الشهر يكون تسعا وعشرين.
“الشهر هكذا يريد أن الشهر قد يكون هكذا أي تسعاً وعشرين، وليس يريد أن كل شهر تسعة وعشرون؛ وذلك لأن الشهر عادةً ثلاثون فوجب بيان الأمر النادر دون المعروف منه”[43]. ومناسبة الباب لسابقه أنه يبين عدة الشهر بعد بيان فرضية الصِّيام، وعلى مَنْ يجب، وفيه أن الشهر القمري يتفاوت في عدد أيامه فتارة يكون تسعاً وعشرين وتارة يكون ثلاثين يوما، وهذا تسلسل منطقي فبيان عدة شهر رمضان أمر له أهمية بالنسبة للصائم.
الباب الخامس: باب إذا أخطأ القوم الهلال:
القوم: “مصدر قام، فوصف به، ثم غلب على الرجال دون النساء”[44]. ومناسبة الباب لسابقه أنه بعد بيان أن الشهر يكون تسعا وعشرين، وضَّح أن من تمام الاهتمام برمضان بيان أن الشهر قد يكون ثلاثين؛ وقد يكون تسعا وعشرين، وبيان الحكم في حال الخطأ، وذلك استكمالا لأبواب ثبوت هلال رمضان.
الباب السادس: باب إذا أُغميَ الشهر.
أُغميَ الشهر: أي أخفي هلال شهر شعبان بنحو غيم، فيكمل عدة شعبان ثلاثين يوما أو يصوم لرمضان، يقال: أغمي الخبر إذا خفي[45].
وإكمال عدة شعبان ثلاثين يوما من باب الاحتياط وذلك لعدم ظهور الهلال، الذي يعتبر البرهان للصيام. ومناسبة الباب للباب السابق أنه يبين أن الخطأ قد يكون بسبب عدم إمكانية رؤية هلال رمضان، فبعد باب الخطأ البشري في رؤية الهلال، جاء الباب الذي يبين الخطأ الناتج عن الغيم؛ وفي ذلك تناسق في ترتيب الأبواب حيث تم بيان الأخطاء الواردة في رؤية الهلال على التوالي.
الباب السابع: باب من قال: فإن غُمّ عليكم فصوموا ثلاثين.
غُمّ عليكم: “أي سُتِر هلال رمضان عليكم فصوموا ثلاثين”[46]. ومناسبة الباب لسابقه أنه في هذا الباب توضيح للباب السابق “باب إذا أُغميَ الشهر”، فهذا الباب دل بوضوح على الحل في حالة غطّى الغيم ولم تتضح الرؤية.
الباب الثامن: باب فِي التَّقَدُّم.
التَّقَدُّم: أي في جواز تقدم الصوم على رمضان[47].
وهذا الباب من قبيل مختلف الحديث فهو يخالف بظاهره ما تقدم من النهي عن تقديم صوم يوم أو يومين على رمضان[48]، ووجه الجمع بينهما أن يقال: إن النهي مقيد بصوم يوم أو يومين، فعلى هذا حكم الجواز في آخر شعبان مختص فيما قبل يوم أو يومين، أو يقال: إن الصوم المعتاد مستثنى من النهي، وحكم جواز التقديم في المعتاد[49]. ومناسبة الباب للباب السابق أنه بعد توضيح أحكام ثبوت رمضان برؤية الهلال، وضّح في هذا الباب حكم التقدم على رمضان بالصِّيام قبله بيوم أو يومين، وفي ذلك استكمال للبيان لأمر الصوم.
الباب التاسع: باب إذا رُئي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة:
إذا رُئي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة؛ أي فما حكمه؟
فهل يعتبر رؤية ذلك البلد للآخرين أم لا؟[50] ومناسبة الباب للباب السابق أنه يبين حكم رؤية الهلال في بلد هل يلزم غيره من البلاد، وذلك بعد باب التقدم على رمضان بصوم يوم أو يومين، وذلك استكمالا لأبواب ثبوت هلال شهر رمضان.
الباب العاشر: باب كراهية صوم يوم الشك:
يوم الشك” هو اليوم الذي يتحدث الناس فيه برؤية الهلال، ولم يثبت رؤيته، هو: يوم الثلاثين من شعبان إذا غُمّ الهلال”[51]. ومناسبة الباب لسبقه أنه بعد الباب الذي بيَّن حكم رؤية هلال رمضان جاء هذا الباب لبيان حكم صوم يوم الشك، والعلاقة هنا هي أن أهل بلد إذا رأوا الهلال وأهل البلد الآخر لم يروه يجب أن يكملوا العدة، فإن صاموا فقد صاموا يوما يشكون فيه، لذلك أعقبه بباب النهي عن صيام يوم الشك.
الباب الحادي عشر: باب فيمن يصل شعبان برمضان
أي: يصل شعبان بصوم آخر أيامه يوما أو يومين برمضان[52]. ومناسبة الباب للباب الذي سبقه أنه بعد بيان الكراهية في صوم يوم الشك في الباب السابق بالنسبة لعامّة المسلمين، ذكر طبيعة صوم الرسول – صلى الله عليه وسلم -، وأنه كان يصوم غالب شهر شعبان، وذلك خاص برسول الله – صلى الله عليه وسلم -، لأن الله يطعمه ويسقيه؛ وهذا من العام المخصوص، فيكره صيام يوم الشك، ويُستثنى من ذلك من كان يصوم الشهر كله أو غالبه استناناً برسول الله – صل الله عليه وسلم -، فله أن يصل شعبان مع رمضان.
الباب الثاني عشر: باب في كراهية ذلك
أي كراهية وصل صوم شعبان برمضان.
قال ابن حجر: “وقال جمهور العلماء بجواز الصوم تطوعا بعد النصف من شعبان”[53]. ومناسبة الباب للباب السابق أنه بعد بيان حكم من يصل صوم شعبان برمضان، أورد باب في كراهية الوصل بين صومهما، أي في هذا الباب أوضح حكم الوصل بين شهري شعبان ورمضان، بعد البيان في الباب السابق لكون الرسول – صلى الله عليه وسلم – كان يصل بين شعبان ورمضان للخصوصية له، وفي هذا الباب بيّن حكم الكراهية لغير الرسول – صلى الله عليه وسلم -.
الباب الثالث عشر: باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال.
في هذا الباب شرط لثبوت شهر شوال شهادة رجلين على رؤية هلال شوال، ومناسبة الباب للباب السابق له أنه بعد بيان أحكام دخول رمضان بيَّن حكم نهاية صوم رمضان ودخول شوال، وفي ذلك تناسق من حيث إثبات دخول شهر رمضان تَبَعا لرؤية الهلال، وكذلك يثبت دخول شوال تَبَعا لرؤية هلاله، وذلك يرتبط برؤية الهلال.
الباب الرابع عشر: باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان
في هذا الباب شرط شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان ومناسبة الباب لسابقه أنه بعد بيان حكم ثبوت هلال شهر شوال وذلك بشهادة رجلين على رؤيته وذلك باتفاق العلماء على ذلك، ناسب توضيح حكم ثبوت رؤية هلال رمضان بشهادة الواحد على ذلك، وفيه بيان الفرق بين هلالي رمضان وشوال، وهذا الباب يعد خاتمة أبواب ثبوت رمضان، وثبوت رمضان هو الأساس الذي يبدأ منه كتاب الصوم؛ فلا صوم للمسلم إلا بعد ثبوت هلال شهر رمضان، ومن عادة الإمام أبي داود – رحمه الله – أنه يترجم للقول الأشهر، ثم لمن خالف.
في المطلب الأول: النَّسق البنائي لأبواب ثبوت رمضان:
بيّن الإمام أبو داود – رحمه الله – في باب مبتدأ فرض الصوم وقد بيّن الله تبارك وتعالى الخط التاريخي للصوم الذي فُرض على الأمم السابقة، ثم اتم الله الدين بفرض الصيام علينا، وفي الباب الذي يليه باب نسخ قوله تعالى { وعلى الذين يطيقونه فدية } بيّن أن الصوم كان على التخيير بين الصوم والفدية؛ وذلك لبيان التدرج في فرض الصوم، ثم باب من قال: هي مثبتة للشيخ والحبلى، والمناسبة أنه خصَّص النص العام في الباب السابق بأفراد مخصوصين وهم الشيخ والحُبْلى؛ ثم جاء بباب الشهر يكون تسعا وعشرين، والمناسبة أنه يبين عِدّة الشهر بعد بيان فرضية الصِّيام، ثم باب إذا أخطأ القوم الهلال وبيان الحكم في حال الخطأ، وذلك استكمالا لأبواب ثبوت هلال رمضان، ثم باب إذا أُغميَ الشهر فبعد بيان الخطأ البشري في رؤية الهلال، جاء الباب الذي يبين الخطأ الناتج عن الغيم؛ وفي ذلك تناسق في ترتيب الأبواب حيث تم بيان الأخطاء الواردة في رؤية الهلال على التوالي. ثم أورد باب من قال: فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين، فهذا الباب دل بوضوح على الحل في حالة غطّى الغيم ولم تتضح الرؤية. ثم باب في التقدُم، ومناسبة الباب للباب السابق أنه بعد توضيح أحكام ثبوت رمضان برؤية الهلال، وضّح في هذا الباب حكم التقدم على رمضان بالصِّيام قبله بيوم أو يومين، وفي ذلك استكمال للبيان لأمر الصوم، ثم باب إذا رئي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة ومناسبة الباب للباب السابق أنه يبين حكم رؤية الهلال في بلد هل يلزم غيره من البلاد، وذلك بعد باب التقدم على رمضان بصوم يوم أو يومين، وذلك استكمالا لأبواب ثبوت هلال شهر رمضان. باب كراهية صوم يوم الشك ومناسبة الباب لما سبقه أنه بعد الباب الذي بيَّن حكم رؤية هلال رمضان جاء هذا الباب لبيان حكم صوم يوم الشك، وفيه النهي عن صيام يوم الشك، ثم باب فيمن يصل شعبان برمضان، ومناسبة الباب للباب الذي سبقه أنه بعد بيان الكراهية في صوم يوم الشك في الباب السابق بالنسبة لعامّة المسلمين، ذكر طبيعة صوم الرسول – صلى الله عليه وسلم -، وأنه كان يصوم غالب شهر شعبان، ثم باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال، ومناسبة الباب لسابقه أنه بعد بيان أحكام دخول رمضان بيَّن حكم نهاية صوم رمضان ودخول شوال وذلك تبعا لرؤية الهلال.
المطلب الثاني: النَّسق البنائي لأبواب السُّحُور.
الباب الخامس عشر: باب في توكيد السُّحُور
السُّحور[54]: “بضم السين: الاكل وقت السَحَر، وبفتحها: ما يؤكل ويشرب في السَحَر”[55].
وهذا الباب في توكيد السُّحُور. ومناسبة الباب للباب السابق أنه بعد بيان أحكام رؤية هلال رمضان، أورد هذا الباب وهو أول أبواب السُّحُور، وذلك الباب حسب الترتيب الزمني يأتي بعد ثبوت هلال شهر رمضان؛ فهو أول ما يفعله الصائم من أحوال الصيام، وفي ذلك تناسق حسب الخط الزمني.
الباب السادس عشر: باب من سمى السُّحُور الْغَدَاء.
الْغَدَاء: “الطعام الذي يؤكل أول النهار، فسمي السُّحُور غَدَاء؛ لأنه للصائم بمنزلته للمفطر[56]“. ومناسبة الباب للباب السابق له أنه بعد باب توكيد السُّحُور، ذكر أن البعض يسمي السُّحُور غَدَاء، وذلك لبيان أسماء السُّحُور؛ وفي ذلك تناسق من حيث استيفاء أسماء السُّحُور، وذلك بعد أن تم تأكيد السُّحُور.
الباب السابع عشر: باب وقت السُّحُور
“في الحديث وضَّح رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أن لا عبرة بالفجر الأول بالبياض الذي يطلع في السماء؛ فهذا البياض هو الفجر الكاذب؛ وأما الفجر الصادق فهو الذي يعتبر به في الإمساك عن الطعام”[57]. ومناسبة الباب أنه جاء بعد توكيد السُّحُور، وبيان ما يسميه البعض، بيَّن وقت السُّحُور، والدقة في تفاصيل الوقت وذلك للحرص على أداء العبادة على أتم وجه، وهذا تناسق وترتيب فبعد التأكد من السُّحُور حدّد وقته.
الباب الثامن عشر: باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده
النِّدَاءُ: رفْعُ الصَّوت وظُهُورُهُ[58]. ومناسبة الباب للذي قبله أنه أورد الباب لبيان وقت السُّحُور، وبيان أن النداء الأخير هو الذي يمسك الصائم لسماعه، أي وقت الإمساك، بعد أن ذكر تسمية السُّحُور بالغداء، وفي ذلك تناسق وترتيب لأبواب السُّحُور، ودقة كبيرة في تحديد وقت السُّحُور لما يترتب عليه من صحة الصوم، وفي هذا الباب بيّن بعض ما يعرض للصائم، وماذا يفعل، وفيه إبراز معالم نسق ترتيب الأبواب للمبحث من خلال النسق الزمني.
في المطلب الثاني: النَّسق البنائي لأبواب السُّحُور:
وفي هذا المطلب وضّح الإمام أبو داود – رحمه الله – ما يتعلق بأحكام السُّحُور ففي باب: في توكيد السُّحُور ومناسبة الباب لما سبقه أنه حسب الترتيب الزمني يأتي بعد ثبوت هلال شهر رمضان؛ فهو أول ما يفعله الصائم من أحوال الصيام، وفي ذلك تناسق حسب الخط الزمني، ثم باب من سمى السُّحُور الغداء والمناسبة بيان أسماء السُّحُور؛ وفي ذلك تناسق من حيث استيفاء أسماء السُّحُور، وذلك بعد أن تم تأكيد السُّحُور، ثم باب وقت السُّحُور، ومناسبة الباب أنه بعد التأكد من السُّحُور حدّد وقته وهذا تناسق وترتيب في تفاصيل ما يتعلق بالسُّحُور، ثم باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده، فقد أورد الباب لبيان وقت السُّحُور، وبيان أن النداء الأخير هو الذي يمسك الصائم لسماعه، أي وقت الإمساك، بعد أن ذكر تسمية السُّحُور بالغداء، وفي ذلك تناسق وترتيب لأبواب السُّحُور.
المبحث الثالث: النَّسق البنائي لأبواب أحكام فطر الصائم، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: النَّسق البنائي لأبواب وقت الفطر.
الباب التاسع عشر: باب وقت فطر الصائم
ابتدأ الإمام أبو داود – رحمه الله – أبواب أحكام فطر الصائم بباب وقت فطر الصائم[59]، ومناسبة الباب للباب السابق أنه بعد إتمام ما يتعلق بأحكام السُّحُور، أتبعه بأحكام الإفطار للصائم، وفي ذلك تناسق حسب الترتيب الزمني، كما هو معلوم أن الصائم يتناول سحوره؛ ثم يتم صومه ويتناول فطوره.
الباب العشرون: باب ما يستحب من تعجيل الفطر.
في هذا الباب استحباب تعجيل الفطر. ومناسبة الباب أنه بعد تحديد وقت الفطر، بيَّن حكم استحباب تعجيل الفطر؛ وذلك بعد بيانه لوقت الفطر فأتبعه بحكم الشرع في استحباب التعجيل في الفطر؛ وذلك اتباعا لسنة الرسول – صلى الله عليه وسلم -، وفي ذلك تناسق في الترتيب حيث يأتي تعجيل الفطر بعد تحديد وقته.
الباب الحادي والعشرون: باب ما يُفطِر عليه.
في هذا الباب ذكر الإمام أبو داود – رحمه الله – ما يُفطِر عليه الصائم. ومناسبة الباب للباب السابق له أنه بعد أن بيَّن حكم استحباب تعجيل الفطر، جاء هذا الباب لبيان ما يُفطِر عليه الصائم، وذلك وفق الترتيب الزمني لأحكام الإفطار.
الباب الثاني والعشرون: باب القول عند الإفطار
في هذا الباب ذكر الإمام أبو داود – رحمه الله – ما يقول الصائم عند الإفطار[60]، أي إذا أفطر. ومناسبة الباب لما سبقه أنه بعد بيان ما يُفطِر عليه وضَّح ما يقول عند الإفطار، وذلك للتسلسل الزمني للصائم حسب زمن الإفطار.
في المطلب الأول: النَّسق البنائي لأبواب وقت الفطر.
في هذا المطلب ابتدأ الإمام أبو داود – رحمه الله – بباب وقت فطر الصائم، ومناسبة الباب لسابقه أنه بعد إتمام ما يتعلق بأحكام السُّحُور، أتبعه بأحكام الإفطار للصائم، وفي ذلك تناسق حسب الترتيب الزمني فالسُّحُور هو السابق للفطور، ثم باب ما يستحب من تعجيل الفطر، ومناسبة الباب بعد بيانه لوقت الفطر أتى بما يُبيّن استحباب التعجيل في الفطر؛ وذلك استنانا برسول الله – صلى الله عليه وسلم -، وفيه تناسق من حيث يَبتغى المسلم تعجيل الفطر بعد تحديد وقته، باب ما يُفطِر عليه، ومناسبته للباب السابق أنه بعد أن بيّان استحباب تعجيل الفطر، بيّنما يُفطِر عليه الصائم، وذلك وفق الترتيب الزمني لأحكام الإفطار، ثم أورد باب القول عند الإفطار والمناسبة أنه بيّن ما يُفطِر عليه، ثم وضَّح ما يقول عند الإفطار، وذلك للتسلسل الزمني للصائم حسب زمن الإفطار.
المطلب الثاني: النَّسق البنائي لأبواب ما يُفطِّر الصائم.
الباب الثالث والعشرون: باب الفطر قبل غروب الشمس
قال ابن حجر: “أي: ظانّاً غروب الشمس ثم طلعت الشمس: هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم أو لا؟، واختلف الناس في وجوب القضاء، فذهب الجمهور إلى إيجاب القضاء، وقال البعض: لا قضاء عليه”[61]. ومناسبة الباب للباب السابق أنه بعد أن ذكر ما يقول الصائم عند الإفطار، ذكر باب من أفطر قبل الغروب، وذلك لاستيعاب أحكام الفطر للصائم.
الباب الرابع والعشرون: باب في الوصال[62].
في هذا الباب أورد الإمام أبو داود – رحمه الله – حكم الوصال في الصوم. ومناسبة الباب للباب السابق أنه بعد أن ذكر حكم من أفطر قبل الغروب، ناسب أن يذكر عكسه وهو من لم يُفطِر عند الغروب وواصل صومه إلى اليوم الموالي.
الباب الخامس والعشرون: باب الغيبة للصائم[63].
وفي هذا الباب حكم الغيبة للصائم. ومناسبة الباب للباب السابق أنه بعد بيان حكم الوصال للصائم، بيَّن حكم الغيبة للصائم، وذلك لاستيفاء أبواب ما يُفطِّر الصائم.
الباب السادس والعشرون: باب السواك للصائم
في هذا الباب حكم السواك للصائم. ومناسبة الباب أنه بعد أن بين حكم الغيبة للصائم، واختلاف العلماء في كونها تفطر[64]، عطف عليها شيئا آخر مما أختلف في كونه مفطرا للصائم وهو السواك، والقاسم المشترك أن الغيبة تخرج من الفم، والسواك يخرج ما في الفم من فضلات أو روائح كريهة ويطهره منها.
الباب السابع والعشرون: باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق.
ومناسبة الباب للباب السابق انه بيَّن في هذا الباب حكم صب الماء على الصائم والاستنشاق للصائم؛ كونهما مظنة دخول شيء من الماء إلى جوف الصائم؛ وذلك استكمالا لأبواب ما يُفطِّر الصائم.
الباب الثامن والعشرون: باب في الصائم يحتجم
وفي هذا الباب بيّن حكم الحجامة. ومناسبة الباب للسابق أن هذا الباب جاء مبينا لحكم الحجامة للصائم، وذلك بعد أن أتم الأحكام المتعلقة بما يُفطِّر الصائم؛ وهذا يأتي تَبَعا لمسألة المُفطِّرات المختلف فيها؛ حسب آراء الفقهاء في هذه المسائل.
الباب التاسع والعشرون: باب في الرخصة في ذلك
أي في الرخصة للصائم بالاحتجام. ومناسبة الباب للباب السابق أنه جاء في هذا الباب الرخصة في الحجامة للصائم بعد النهي عنها للصائم، وفي ذلك سعة وترخيص لمن احتجم وهو صائم، وفي ذلك تناسق بين الأبواب إذ أورد الرخصة بعد النهي.
الباب الثلاثون: باب في الصائم يحتلم نهارا في رمضان.
في هذا الباب بيان لحكم الاحتلام للصائم. ومناسبة الباب لسابقه أن هذا الباب جاء استكمالا لأبواب ما يُفطِّر الصائم؛ فبعد باب الحجامة، أورد باب الصائم يحتلم نهارا وهل هي من المفطرات أم لا.
الباب الحادي والثلاثون: باب في الكحل عند النوم للصائم
والذي يبدو أن الحديثين متعارضين ظاهرياً؛ ففي الحديث الأول قال – صلى الله عليه وسلم – ليتقه الصائم، أي فيه النهي عن الكحل للصائم، والحديث الثاني[65] يبين أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – اكتحل وهو صائم.
قال يحيى بن معين: هو منكر، يعني حديث الكحل؛ لأنه مخالف فعل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فإنه اكتحل وهو صائم[66] الحديث ضعيف لا ينتهض للاحتجاج به[67]. ومناسبة الباب أنه بعد استكمال أبواب ما يُفطِّر الصائم، أورد بعد باب احتلام الصائم وهذا الباب غير مُختَلَف عليه، وأورد بعده باب حكم الكحل للصائم عند النوم، وهذا من الأمور المُختَلف فيها عند العلماء؛ فناسب أن يورد بعد ما ليس فيه اختلاف، بعد ما اختُلفَ فيه.
الباب الثاني والثلاثون: باب الصائم يستقيء عامدا
قال الخَطَّابي: لا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقاء عامدا أن عليه القضاء[68]. ومناسبة الباب للباب السابق وهو باب الكحل عند النوم للصائم، وفيه أن جمهور العلماء على أنه لا يُفطِّر، أورد باب الصائم يستقيء عامدا والعلماء على أنه مما يُفطِّر الصائم، وهنا قد أورد عكس الحكم في الباب السابق له؛ وهو أن الصائم لا يُفطِر إذا اكتحل، وأتبعه بباب يحمل عكس الحكم، وهذا فيه تناسق في إيراد عكس الحكم في الباب الذي يليه.
الباب الثالث والثلاثون: باب القُبْلة للصائم
أي هذا باب في بيان حكم المباشرة للصائم، المباشرة مفاعلة وهي الملامسة، وأصله من لمس بشرة الرجل بشرة المرأة[69].ومناسبة الباب أنه جاء ضمن أبواب ما يُفطِّر الصائم، بعد بيان باب الصائم يستقيء عامدا، فجاء بباب القُبْلة للصائم، وفي ذلك تناسق بين الأبواب التي يكون فيها فعل فيه تعمد من الصائم له.
الباب الرابع والثلاثون: باب الصائم يبلع الريق.
ومناسبة هذا الباب للباب السابق جاء في هذا الباب ليكمل أبواب ما يُفطِّر الصائم، وجاء بعد باب الصائم يُقَّبل زوجه، بباب الصائم يبلع الريق؛ وفي ذلك تناسب بين تقبيل الزوج، وما يتبع ذلك من أمور، وذلك يتناغم مع استيفاء أبواب ما يُفطِّر الصائم.
الباب الخامس والثلاثون: باب كراهيته للشاب
أي كراهية المباشرة مثل القبلة واللمس للشاب[70]. ومناسبة الباب أنه بعد الباب الذي بيّن فيه حكم تقبيل الزوج لأهله، وما يتبعه من المباشرة للزوجة، جاء بالباب الذي يُبيّن فيه حكم المباشرة للشاب، وفيه تفصيل بين الشاب والشيخ، وفي ذلك تناسق قي استكمال أبواب ما يُفطِّر الصائم؛ وذلك للاحتراز في أمر الصوم لأهمية أمره؛ وهو الركن الثالث من أركان الإسلام.
الباب السادس والثلاثون: باب من أصبح جُنُبًا في شهر رمضان.
في هذا الباب حكم من أصبح جُنُبًا في رمضان ومناسبة الباب للباب السابق أنه بعد البيان لحكم مباشرة الصائم لأهله، جاء هذا الباب لبيان حكم الصائم إذا أصبح جُنُبًا في رمضان، وفي ذلك تناسق وتناغم بين هذه الأبواب، حيث أورد الباب الذي ليس فيه عمد للصائم وهو إذا أصبح جُنُبًا في رمضان، بعد باب مباشرة الصائم لأهله بتعمد من الصائم؛ وفي ذلك تناسق وتناغم إذ أورد باب ما لا تعمُد للصائم فيه بعد باب ما كان بعمد من الصائم.
الباب السابع والثلاثون: باب كفارة من أتى أهله في رمضان
ومناسبته للباب السابق أنه بعد باب من أصبح جُنُبًا في شهر رمضان، أورد باب كفارة من أتى أهله في رمضان، وهذا تناسب بين البابين حيث أتبع باب ما ليس فيه عمد للصائم وهو أن يصبح جنبا، بباب كفارة من أتى أهله في رمضان، وفي هذا الباب عمد من الصائم. حيث يُنظر إليهما على أنهما ممَّا يُفطِّر الصائم.
الباب الثامن والثلاثون: باب التغليظ فيمن أفطر عمدا
في هذا الباب بيان التغليظ فيمن أفطر عمدا. ومناسبة الباب أن الإمام أبو داود – رحمه الله – ذكره بعد باب كفارة من أتى أهله في نهار رمضان، وفيه بيان التغليظ على من يفطر متعمدا، وهذه الأمور مما يفطر الصائم، إذ أتى بباب التغليظ على من يُفطر متعمدا؛ بعد باب كفارة من أتى أهله في نهار رمضان، وفي ذلك تناسب وتناسق في ترتيب الأبواب؛ حيث أتى بباب التغليظ بعد باب الكفارة لمن أفطر متعمدا.
الباب التاسع والثلاثون: باب من أكل ناسيا.
معنى الترجمة: أي ما حكمه هل يسلم له صومه، ولا يجب عليه قضاء ذلك اليوم أم لا؟[71]. ومناسبة الباب لسابقه أنه جاء في هذا الباب بحكم من أكل أو شرب ناسياً، بعد باب التغليظ فيمن أفطر عمدا؛ وهذا متناسق من حيث أن الإمام أبو داود – رحمه الله – أورد الباب فيمن أفطر عمدا، ثم الباب فيمن أكل ناسيا في رمضان.
الباب الأربعون: باب تأخير قضاء رمضان
مناسبة الباب للباب السابق أنه جاء ترتيب الباب متناسقاً مع الباب السابق، الذي أتم ذكر ما يفطر الصائم، وتلاه هذا الباب الذي يبين وقت قضاء الصوم، فجاء التوقيت للقضاء، بداية لما يتمم توضيح أبواب ما يتعلق بالصِّيام، فالقضاء لمن افطر في رمضان يأتي بعد الإفطار في العادة؛ وذلك حسب الترتيب الزمني.
الباب الحادي والأربعون: باب فيمن مات وعليه صيام
مناسبة الباب للباب السابق أن هذا الباب جاء بعد باب تأخير قضاء رمضان، أي هل يُصام عنه بعد وفاته فيجوز تأخيره، و
في ذلك بيان واضح متناسق بين تأخير القضاء للصائم، وتأخير القضاء عمن مات وعليه صيام؛ فكلاهما يتحدث عن القضاء للصوم.
وفي المطلب الثاني: النَّسق البنائي لأبواب ما يُفطِّر الصائم.
بيّن الإمام أبو داود – رحمه الله – في هذا المطلب أحكام ما يُفطِّر الصائم؛ فبدأ بباب الفطر قبل غروب الشمس بعد بيان قول الصائم عند الإفطار، وفي ذلك استيعاب أحكام الفطر للصائم، وبيّن حكم الوصال؛ والمناسبة ذكر عكسه أي من واصل صومه إلى اليوم الموالي، ثم حكم الغيبة للصائم، لاستيفاء أبواب ما يُفطِّر الصائم، ثم بيان حكم السواك للصائم، وكلاهما مما أختُلف في كونه مفطرا للصائم وهو السواك، والقاسم المشترك أن الغيبة تخرج من الفم، والسواك يخرج ما في الفم من فضلات أو روائح كريهة ويطهره منها، ثم حكم الصائم يَصُبُّ عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق، كونهما مظنة دخول شيء من الماء إلى جوف الصائم؛ وفيه استكمالا للأبواب ما يُفطِّر الصائم، ثم بيان حكم الحجامة والمناسبة بيان الرخصة في الاحتجام للصائم والتناسق في إيراد الرخصة بعد النهي، ثم بيّن حكم الاحتلام للصائم نهارا في رمضان وجاء استكمالا لأبواب ما يُفطِّر الصائم؛ وهل هي من المفطرات أم لا، والكحل عند النوم للصائم، وهو من الأمور المُختَلف فيها عند العلماء؛ فناسب أن يُورد بعد ما ليس فيه اختلاف، بعد ما اختُلفَ فيه، ثم حكم القيء عامدا، والعلماء على أنه مما يُفطِّر الصائم، فأورد عكس الحكم وفي ذلك تناسق في إيراد عكس الحكم في الباب الذي يليه، ثم جاء بباب القُبْلة للصائم، ضمن أبواب ما يُفطِّر الصائم، والتناسق بين الأبواب التي يكون فيها فعل فيه تعمد من الصائم له، وأتبعه بباب الصائم يبلع الريق، ليكمل أبواب ما يُفطِّر الصائم، وفي ذلك تناسب بين تقبيل الزوج، وما يتبع ذلك من أمور، وذلك يتناغم مع استيفاء أبواب ما يُفطِّر الصائم، ثم أورد باب كراهية المباشرة مثل القُبلة واللمس للشاب، والمناسبة أنه جاء بالباب الذي يُبيّن فيه حكم المباشرة للشاب، وفيه تفصيل بين الشاب والشيخ، وفي ذلك تناسق قي استكمال أبواب ما يُفطِّر الصائم، ثم باب من أصبح جُنُبًا في شهر رمضان، ومناسبة الباب للباب السابق أنه بعد البيان لحكم مباشرة الصائم لأهله، بيّن حكم الصائم إذا أصبح جُنُبًا في رمضان، وفي ذلك تناسق وتناغم الأبواب، حيث أورد الباب الذي ليس فيه عمد للصائم، بعد ما فيه تعمد، ثم باب كفارة من أتى أهله في رمضان والمناسبة للباب السابق أنه بعد باب من أصبح جُنُبًا في شهر رمضان، أورد باب كفارة من أتى أهله في رمضان، وفي ذلك تناسب بين البابين حيث أتبع باب ما ليس فيه عمد للصائم بباب ما فيه عمد من الصائم، ثم باب التغليظ فيمن أفطر عمدا، وهذه الأمور مما يُفطِّر الصائم، وفي ذلك تناسب وتناسق في ترتيب الأبواب حيث فيه بيان للمتعمد للفطر، وأتبعه بباب من أكل ناسيا، وهذا متناسق من حيث أن الإمام أبو داود – رحمه الله – أورد الباب فيمن أفطر عمدا، ثم الباب فيمن أكل ناسيا في رمضان، ثم باب تأخير قضاء رمضان، فجاء التوقيت للقضاء، بداية لما يتمم توضيح أبواب ما يتعلق بالصِّيام، فالقضاء لمن افطر في رمضان يأتي بعد الإفطار في العادة؛ وذلك حسب الترتيب الزمني، ثم باب فيمن مات وعليه صيام، ومناسبة الباب لسابقه أن فيه بيان واضح متناسق بين تأخير القضاء للصائم، وتأخير القضاء عمن مات وعليه صيام؛ فكلاهما يتحدث عن القضاء للصوم.
المبحث الرابع: النَّسق البنائي لأبواب أحكام صوم المسافر، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: النَّسق البنائي لاختيار الصوم أو الفطر للمسافر
الباب الثاني والأربعون: باب الصوم في السفر
أورد الإمام أبو داود – رحمه الله – باب الصوم في السفر. ومناسبة الباب للباب السابق أنه لما فرغ من ذكر باب من مات وعليه صيام أتبعه بباب الصوم للمسافر؛ هل يلتحق به في عدم الصوم وتأخير القضاء؛ وفي هذا مراعاة لترتيب الآية: فمن كان منكم مريضا أو على سفر.
الباب الثالث والأربعون: باب اختيار الفطر.
في هذا الباب أورد الإمام أبو داود – رحمه الله – باب اختيار الفطر. ومناسبة الباب أنه جعل الصوم للمسافر في بابين، وعنوان الباب الأول عام وما تحته من أحاديث تفيد العزيمة والرخصة، وقدّم العزيمة ثم أتبعه بباب مستقل للرخصة.
الباب الرابع والأربعون: باب من اختار الصِّيام
وذلك أن الصوم والإفطار في السفر لو لم يكونا مباحين لما صام النبي – صلى الله عليه وسلم – وابن رواحة، وأفطر الصحابة – رضي الله تعالى عنهم –[72]، والأمر فيه محمول على الندب والحث على الأوْلى والأفضل للنصوص الدالة على جواز الإفطار في السفر مطلقا[73]. ومناسبة الباب للباب السابق أنه بعد أن أورد في الباب السابق حكم من اختار الفطر، جاء في هذا الباب حكم من اختار الصِّيام وأخذ بالعزيمة ليأتي بكل الأبواب الخاصة بصوم المسافر، لاستكمال حكم الصِّيام للمسافر.
وفي المطلب الأول: النَّسق البنائي لاختيار الصوم أو الفطر للمسافر
بدأ الإمام أبو داود – رحمه الله – هذا المطلب بباب الصوم في السفر، ومناسبة الباب للباب السابق أنه لما فرغ من ذكر باب من مات وعليه صيام أتبعه بباب الصوم للمسافر؛ وفي هذا مراعاة لترتيب الآية: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٖ﴾[74]، ثم باب اختيار الفطر ومناسبة الباب أنه جعل الصوم للمسافر في بابين، وعنوان الباب الأول عام وما تحته من أحاديث تفيد العزيمة والرخصة، وقدّم العزيمة ثم أتبعه بباب مستقل للرخصة، ثم باب من اختار الصِّيام، ومناسبة الباب للباب السابق أنه بعد أن أورد حكم من اختار الفطر، أتبعه بباب حكم من اختار الصِّيام وأخذ بالعزيمة ليأتي بكل الأبواب الخاصة بصوم المسافر، لاستكمال حكم الصِّيام للمسافر.
المطلب الثاني: النَّسق البنائي لوقت ومسافة الفطر للصائم
الباب الخامس والأربعون: باب متى يفطر المسافر إذا خرج
في هذا الباب يُبين متى يفطر المسافر إذا خرج، أي هل يفطر أثناء النهار أم لا. ومناسبة الباب للباب السابق أنه بعد باب من اختار الصِّيام، جاء هذا الباب ليوضح لنا حكم متى يُفطِر المسافر إذا خرج، وفي ذلك تناسق لترتيب أمور الصِّيام؛ جاء ببيان متى يفطر، وهذا من إتمام الأبواب التي تتحدث عن صوم المسافر.
الباب السادس والأربعون: باب قدر مسيرة ما يفطر فيه
قدر مسيرة ما يفطر فيه: شهر أي المسافة التي يسار فيها من الأرض[75]. ومناسبة الباب للذي قبله انه بعد باب متى يفطر المسافر إذا خرج، جاء بباب قدر مسيرة ما يفطر فيه، وفي هذا تناسق بعد بيان وقت فطر المسافر بيَّن المسافة التي يفطر فيها المسافر.
الباب السابع والأربعون: باب من يقول: صمت رمضان كله.
في هذا الباب حكم من قال: صمت رمضان كله. ومناسبة الباب للباب السابق أنه بعد الباب الذي حدد فيه مقدار مسيرة ما يفطر فيه المسافر، جاء بباب من يقول: صمت رمضان كله، وهل من أفطر في رمضان بسبب السفر وقضى ما أفطر؛ هل يدخل في حكم من صام رمضان كاملا ويصدق عليه أنه صام رمضان كله، وذلك لاستغراق أبواب صوم المسافر.
وفي المطلب الثاني: النَّسق البنائي لوقت ومسافة الفطر للصائم
أورد الإمام أبو داود – رحمه الله – أبواب وقت السفر ومسافة الفطر، وبدأ بباب متى يفطر المسافر إذا خرج،
والمناسبة أنه جاء هذا الباب ليوضح لنا حكم متى يُفطِر المسافر إذا خرج، وفي ذلك تناسق في ترتيب أمور الصِّيام؛
وجاء ببيان متى يفطر، وهذا من إتمام الأبواب التي تتحدث عن صوم المسافر، ثم باب قدر مسيرة ما يفطر فيه، ومناسبة الباب للذي قبله انه بعد بيان متى يفطر المسافر إذا خرج، جاء بباب قدر مسيرة ما يفطر فيه، وفي هذا تناسق إذ بيّن وقت الفطر للمسافر والمسافة التي يفطر فيها، ثم باب من يقول: صمت رمضان كله. ومناسبة الباب للباب السابق أنه بعد أن حدّد مقدار مسيرة ما يفطر فيه المسافر، جاء بباب من يقول: صمت رمضان كله، وهل يدخل من أفطر في رمضان بسبب السفر وقضى ما أفطر في حكم من صام رمضان كاملا ويصدق عليه أنه صام رمضان كله، وذلك لاستغراق أبواب صوم المسافر.
المبحث الخامس: النَّسق البنائي لأبواب صوم النافلة والاعتكاف، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: النَّسق البنائي لأبواب ما يكره من صوم النافلة
الباب الثامن والأربعون: باب في صوم العيدين
ابتدأ الإمام أبو داود – رحمه الله – أبواب ما يكره من صوم النافلة بباب في صوم العيدين. ومناسبة ذلك الباب للباب السابق أنه بدأ بالعيد لأنه أول يوم يكره صومه بعد انقضاء رمضان، ثم يليه عيد الأضحى، ثم ثلاثة أيام التشريق على الترتيب الزمني.
الباب التاسع والأربعون: باب صيام أيام التشريق
أيام التشريق: “وهي ثلاثة أيام تلي عيد النحر، سُميت بذلك من تشريق اللحم، أي تقديده وبسطه في الشمس ليجف”[76].ومناسبة الباب للباب السابق أنه بعد أن ذكر في الباب السابق حكم صوم العيدين ونهي الرسول – صلى الله عليه وسلم – عن صومه، أورد في هذا الباب حكم صيام أيام التشريق، وفي هذا تناسق حيث أورد أبواب الصيام المنهي عنه في نسق وتناغم.
الباب الخمسون: باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم
في هذا الباب نهي عن ان يخص يوم الجمعة بصوم. ومناسبة الباب هو أنه بعد ذكر باب صيام أيام التشريق والنهي
عن صيامها جاء بباب النهي عن أن يخص يوم الجمعة بصوم، والتناسب ظاهر في ذلك فقد استكمل أبواب النهي عن صوم أيام معينة مثل صوم العيدين، وأيام التشريق، وإفراد يوم الجمعة بصوم.
الباب الحادي والخمسون: باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم.
مناسبة هذا الباب للباب السابق أنه بعد الحديث عن النهي عن أن يخص يوم الجمعة بصوم، جاء الباب الذي يليه وفيه النهي عن أن يخص يوم السبت بصوم وهذا فيه التناسق من حيث أن الأبواب جاءت في النهي عن صيام أيام معينة، وفي ترتيب الأيام فيوم السبت هو اليوم الذي يلي يوم الجمعة.
الباب الثاني والخمسون: باب الرخصة في ذلك
أي في تخصيص يوم السبت بصوم. ومناسبة الباب للباب السابق أنه بعد باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم، أورد باب الرخصة في ذلك، وهذا فيه تناسق في إيراد الرخصة بعد النهي للتيسير والتوسعة على المسلمين.
الباب الثالث والخمسون: باب في صوم الدهر تطوعا
مناسبة الباب للباب السابق أنه بعد الفراغ من الأبواب التي تضمنت النهي عن صيام أيام مخصوصة، ختمها بباب تضمن النهي عن صوم الدهر تطوعا.
وفيه” بيان رفق رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بأمته وشفقته عليهم وإرشادهم إلى مصالحهم وحثهم على ما يطيقون الدوام عليه ونهيهم عن التعمق والإكثار من العبادات التي يخاف عليهم الملل بسببها أو تركها أو ترك بعضها، وفي هذه الرواية النهي عن صيام الدهر”[77].
الباب الرابع والخمسون: باب في صوم أشهر الحرم
“أمر الرسول – صلى الله عليه وسلم – بصيام شهر رمضان شهر الصبر، والصِّيام لأيام من الأشهر الحرم والترك منها، أي أن يصوم من الأشهر الحرم ثلاثة أيام، وثلاثة أيام من كل شهر من الأشهر الباقية”[78]. ومناسبة الباب للباب السابق أنه بعد ما جاء في باب صوم الدهر تطوعا، أتبعه بباب صوم الأشهر الحرم، وفي ذلك الانتقال من العام إلى الخاص، من صوم الدهر إلى صوم بعض الأشهر.
وفي المطلب الأول: النَّسق البنائي لأبواب ما يكره من صوم النافلة
أورد الإمام أبو داود – رحمه الله – في هذا المطلب سبعة أبواب فيما يكره من صوم النافلة، وابتدأ الإمام أبو داود – رحمه الله – بباب في صوم العيدين، ومناسبة ذلك الباب للباب السابق أنه بدأ بالعيد لأنه أول يوم يكره صومه بعد انقضاء رمضان، ثم يليه عيد الأضحى، ثم ثلاثة أيام التشريق وفي ذلك تناسق حسب الترتيب الزمني، ثم صيام أيام التشريق، والمناسبة بيان التناسق في أبواب الصيام المنهي عنه في نسق وتناغم، ثم باب النهي أن يخص يوم الجمعة أو السبت بصوم، والتناسب ظاهر في ذلك فبعد استكمال أبواب النهي عن صوم أيام معينة، ظهر التناسق من حيث ترتيب الأيام فيوم السبت هو اليوم الذي يلي يوم الجمعة، وهذا تناسق زمني، ثم باب الرخصة في تخصيص يوم السبت بصوم، وهذا فيه تناسق في إيراد الرخصة بعد النهي للتيسير والتوسعة على المسلمين، ثم باب في صوم الدهر تطوعا والمناسبة لسابقه أنه بعد الفراغ من الأبواب التي تضمنت النهي عن صيام أيام مخصوصة، ختمها بباب تضمن النهي عن صوم الدهر تطوعا، وفيه بيان رفق رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بأمته وشفقته عليهم، وإرشادهم إلى مصالحهم، وحثهم على ما يطيقون الدوام عليه ونهيهم عن التعمق والإكثار من العبادات التي خشية الملل المؤدي لتركها أو ترك بعضها، ثم أورد باب في صوم أشهر الحُرُم ومناسبة الباب لسابقه أنه صوم الدهر تطوعا، أتبعه بباب صوم الأشهر الحرم، وفي ذلك الانتقال من العام إلى الخاص، من صوم الدهر إلى صوم بعض الأشهر.
المطلب الثاني: النَّسق البنائي لأبواب استحباب صوم النافلة
الباب الخامس والخمسون: باب في صوم المُحَّرم
أي صيام شهر الله، والإضافة إلى الله للتشريف[79]. ومناسبة الباب للباب السابق أنه بعد إيراد باب صوم أشهر الحرم، جاء بباب صوم المُحَرم، وفي هذا ذكر الخاص بعد العام، وهذا فيه تناسق حيث يورد الخاص بعد العام.
الباب السادس والخمسون: باب في صوم شعبان
ومناسبة الباب للباب السابق أنه بعد باب صوم المُحَرم، ذكر باب صوم شعبان، وفي ذلك تناسق في الترتيب الزمني
فشهر المُحرّم قبل شهر شعبان، وفيه ذلك تناسق في استيفاء أبواب النوافل المستحبة من الصِّيام.
الباب السابع والخمسون: باب في صوم شوال
ومناسبة الباب للباب السابق أنه بعد ذكر باب صوم شعبان، أتبعه بباب صوم شوال، وفيه تناسق من حيث الترتيب الزمني؛ فشهر شعبان يأتي قبل شهر شوال، وفي ذلك تناسق في استيفاء أبواب النوافل المستحبة من الصِّيام.
الباب الثامن والخمسون: باب في صوم ستة أيام من شوال
ومناسبة الباب للباب السابق أنه بعد أن ذكر باب صوم شوال بعمومه، أورد باب صوم ستة أيام من شوال، أي جاء بالخاص بعد العام.
الباب التاسع والخمسون: باب كيف كان يصوم النبي – صلى الله عليه وسلم –
“وفي هذا الباب أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كان لا يخلي شهرا من صيام، ليبين أن صوم النفل غير مختص بزمان معين بل كل السنة صالحة له إلا رمضان والعيد والتشريق، قيل: كان يصوم شعبان كله في وقت ويصوم بعضه في سنة أخرى”[80].
ولم يكن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يتم صيام شهر سوى شهر رمضان. ومناسبة الباب للباب السابق أنه بعد باب صوم الستة من شوال، أورد باب كيف كان يصوم النبي – صلى الله عليه وسلم -، وذلك استكمالاً لبيان سنة الرسول – صلى الله عليه وسلم – في الصِّيام، والأيام التي كان يصومها، وكأنه أراد أن يجعل ختام الأبواب له علاقة بصيام رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وهو خير ختام.
الباب الستون: باب في صوم الاثنين والخميس
في هذا الباب بيان لاستحباب صوم يوم الاثنين والخميس لأن الأعمال تُعرض فيهما.
“تعرض أعمال العباد يوم الاثنين ويوم الخميس يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل”[81]. ومناسبة الباب للباب السابق أنه بعد أن ذكر باب كيف كان يصوم النبي – صلى الله عليه وسلم -، أورد باب في صوم الاثنين والخميس، وفي ذلك تناسق، في ترتيب أحاديث أبواب استحباب صوم النافلة.
الباب الحادي والستون: باب في صوم العشر
“وفي الباب تفضيل بعض الأزمنة على بعض كالأمكنة، وفضل أيام عشر ذي الحجة على غيرها من أيام السنة[82]“. ومناسبة الباب للباب السابق أنه بعد ذكر باب صوم الاثنين والخميس، ذكر باب صوم العشر، وهذا متناسق من حيث أن هذه الأبواب كلها من زمرة صوم النوافل؛ وهي جميعا من المستحبات في صوم النافلة.
الباب الثاني والستون: باب في فطر العشر
قال ابن حجر: “في ذلك بيان فضل صيام عشر ذي الحجة؛ لاندراج الصوم في العمل”[83]. ومناسبة الباب للباب السابق أنه بعد باب في صوم العشر، جاء باب في فطر العشر لبيان الرخصة في الفطر[84].
الباب الثالث والستون: باب في صوم عرفة بعرفة
“صوم يوم عرفة منهي عنه لمن بات بعرفة، مندوب لغيرهم”[85]، “وإنما نهى المحرم عن ذلك خوفا عليه أن يضعف عن الدعاء والابتهال في ذلك المقام”[86] ومناسبة الباب للباب السابق أنه بعد ذكر باب فطر العشر، أورد باب صوم عرفة بعرفة، وفي ذلك تناسق في الترتيب الزمني، فبعد باب فطر العشر، أورد باب صوم عرفة بعرفة وهو منهي عنه للصائم، وكلا البابين في فطر العشر والنهي عن صوم عرفة للحاج بعرفة.
الباب الرابع والستون: باب في صوم يوم عاشوراء
عاشوراء: عاشر المُحَّرم، ويستحب صيامه مع اليوم التاسع، أو مع اليوم الحادي عشر[87]. ومناسبة الباب للباب السابق أنه بعد أن جاء بباب صوم عرفة بعرفة، أورد باب صوم يوم عاشوراء، وفي ذلك تناسق في الترتيب من حيث الخط الزمني فعاشوراء في شهر المحرم الذي يلي شهر ذي الحجة وهو آخر الأشهر الهجرية، وذلك فيه تناسق من حيث أن هذه الأيام كلها من الأيام التي يستحب صيامها، أما صوم يوم عرفة فيستحب صيامه لغير الحاج.
الباب الخامس والستون: باب ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع
ومناسبة الباب للباب السابق أنه بعد باب صوم يوم عاشوراء، أورد باب ما رُوي أن عاشوراء اليوم التاسع، وهذا ما سار عليه الإمام أبو داود – رحمه الله – في ذكر القول المشهور ثم يتبعه بما اختلف فيه العلماء.
الباب السادس والستون: باب في فضل صومه
أي صوم يوم عاشوراء. ومناسبة الباب للباب السابق أنه بعد باب ما رُوي أن عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم وهذا هو الأظهر، ثم باب ما رُوي أن عاشوراء اليوم التاسع، أورد باب في فضل صومه، وفي ذلك استكمال لأبواب صوم يوم عاشوراء، وذِكر الفضل في نهاية الأبواب فيه تناسق، حيث يعتبر متمما وختاما لما يتعلق بصوم عاشوراء.
الباب السابع والستون: باب في صوم يوم وفطر يوم
أي في فضله.
قال الخَطَّابي: “إن الله تعالى لم يتعبد عبده بالصوم خاصة، بل تعبده بأنواع من العبادات، فلو استفرغ جهده لقصر في غيره، فالأولى الاقتصاد فيه ليستبقي بعض القوة لغيره”[88].
“وفي الباب بيان رفق رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بأمته، وشفقته عليهم، وإرشادهم إلى مصالحهم، وحثهم على ما يطيقون الدوام عليه، ونهيهم عن التعمق والإكثار من العبادات التي يخاف عليهم الملل بسببها أو تركها أو ترك بعضها”[89]. ومناسبة الباب للباب السابق أنه بعد باب في فضل صوم عاشوراء، أورد باب في صوم يوم وفطر يوم، وهذا فيه تناسق في الانتقال من فضل عاشوراء إلى الأفضل وهو أحب الصِّيام إلى الله.
الباب الثامن والستون: باب في صوم الثلاث من كل شهر
الثلاث: “أي الأيام البيض وهي أيام الليالي البيض هي أيام الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر من الشهر القمري؛ وسميت بذلك لابيضاض ليلها كله بضوء القمر”[90].
مناسبة الباب: بعد أن بيَّن أفضل الصِّيام في باب صوم يوم وفطر يوم، بيَّن استحباب صوم الثلاث من كل شهر، في الباب الذي تلاه، وقد انتقل من الأعم إلى الأكثر خصوصيةٍ؛ وذلك بصوم الثلاث من كل شهر، وفي ذلك تناسق في بيان أبواب الصوم المستحب.
الباب التاسع والستون: باب من قال الاثنين والخميس ،
في هذا الباب صوم ثلاثة من كل شهر الاثنين والخميس، وفيما قبله الصوم الثلاثة أيام البيض ولا منافاة بينهما، فإنه كان مرة كذا ومرة كذا[91]. ومناسبة الباب للباب السابق أنه بعد باب صوم الثلاث في أيام الليالي البيض، أورد باب من قال يصوم ثلاثة من كل شهر الاثنين والخميس، ثم الإثنين من الجمعة التالية، وهذا أعم من الباب السابق؛ حيث يكون الصوم في أول الشهر وأوسطه وآخره، وذلك يتناسق مع أن في كليهما صوم ثلاثة أيام من كل شهر.
الباب السبعون: باب من قال لا يبالي من أي الشهر
ومناسبة الباب للباب السابق أنه بعد باب من قال الإثنين والخميس، أورد باب من قال لا يبالي من أي الشهر، وفي ذلك تناسق من حيث أن المطلوب صيام ثلاثة أيام من الشهر، سواء كان الصِّيام يومي الإثنين والخميس ويوم إثنين من الأسبوع التالي، أم أي ثلاثة أيام من الأول له أم من وسطه أم آخره، ثم جاء ببيان أن الأهمية للصيام في أي وقت من الشهر.
الباب الحادي والسبعون: باب النية في الصوم
ومناسبة الباب للباب السابق أنه بعد بيان أيام صوم النفل في باب من قال لا يبالي من أي الشهر، أو الأيام البيض، أورد باب النية في الصوم، ومناسبة تأخير باب النية حتى ذكر أبواب صوم النافلة مع أن حقها التقديم لبيان التفصيل في اختلاف نية صوم النافلة عن الصوم الواجب ولكي يتجنب تكرار ذكر باب النية في أكثر من موضع كما جعلها في باب مختلف الحديث ونسقه في مختلف الحديث ان يذكر الاختلاف في بابين متتاليين.
الباب الثاني والسبعون: باب في الرخصة فيه
الرخصة فيه: أي في ترك النية للصوم بالليل[92].
قال الخَطَّابي: “فيه جواز تأخير نية الصوم عن أول النهار إذا كان تطوعا، وجواز إفطار الصائم قبل الليل إذا كان متطوعا به[93]” ومناسبة الباب للباب السابق أنه بعد باب النية في الصوم أي تبييت النية، أورد باب في الرخصة في الصوم من غير تبييت للنية، وفي ذلك تناسق بين الترخيص في الصوم بالنية في نهار اليوم للصائم، وتبييت النية.
الباب الثالث والسبعون: باب من رأى عليه القضاء
ومناسبة الباب للباب السابق أنه بعد باب الرخصة في ترك نية الصوم في الليل في صوم التطوع، أورد باب من رأى عليه القضاء، والعادة عند أبي داود – رحمه الله – أن يورد الباب في القول المشهور أولاً، ثم يُتبعه بالرأي الآخر، وهذا النَّسق الذي سار عليه الإمام أبي داود – رحمه الله – في سننه.
الباب الرابع والسبعون: باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها
ومناسبة الباب للباب السابق أنه بعد باب من رأى القضاء على من أفطر في صوم التطوع، أورد باب المرأة تصوم تطوعاً بغير إذن زوجها، لبيان أحكام صوم التطوع واستكمالها.
الباب الخامس والسبعون: باب في الصائم يُدعى إلى وليمة
ومناسبة الباب للباب السابق أنه بعد باب صوم المرأة بغير إذن زوجها في صيام التطوع، أورد باب في الصائم يُدعى إلى وليمة، وفي ذلك تناسق بين البابين في صوم المرأة بغير إذن زوجها وزوجها يدعوها للفطر، وباب الصائم في صوم التطوع أنه يفطر إذا دُعيَ إلى وليمة؛ فالمرأة الصائمة بغير إذن زوجها تفطر، والصائم المدعو إلى وليمة؛ لا يفطر وإنما يدعو لصاحب الوليمة.
الباب السادس والسبعون: باب ما يقول الصائم إذا دُعِيَ إلى الطعام
ومناسبة الباب للباب السابق أنه بعد باب دعوة الصائم إلى وليمة، جاء في الباب الذي يليه باب ما يقول الصائم إذا دعي إلى الطعام وذلك إن لم يجب الدعوة بالأكل من الطعام، اعتذر بقوله إني صائم، وفي ذلك تناسق وتناسب واضح بين الاستجابة للدعوة وبين الاعتذار عن الدعوة، فالاعتذار يكون تاليا للدعوة، الصائم يتلقى الدعوة؛ ثم يجيب الداعي بتلبية دعوته أو الاعتذار عنها.
وفي المطلب الثاني: النَّسق البنائي لأبواب استحباب صوم النافلة
أورد الإمام أبو داود – رحمه الله – في هذا المطلب واحدا وعشرين بابا، وقد بدأ بباب صوم المُحَّرم والمناسبة أنه بعد إيراد باب صوم أشهر الحُرُم، جاء بباب صوم المُحَرم، وهذا فيه تناسق حيث يورد الخاص بعد العام، ثم باب في صوم شعبان، وفي ذلك تناسق في الترتيب الزمني فشهر المُحرّم قبل شهر شعبان، وفي ذلك تناسق في استيفاء أبواب النوافل المستحبة من الصِّيام، ثم باب في صوم شوال، وفيه تناسق من حيث الترتيب الزمني؛ فشهر شعبان يأتي قبل شهر شوال، ثم باب في صوم ستة أيام من شوال، والمناسبة أنه جاء بالخاص بعد العام، ثم باب كيف كان يصوم النبي – صلى الله عليه وسلم -، والمناسبة في إيراد الباب أنه استكمال لبيان سنة الرسول – صلى الله عليه وسلم – في الصِّيام، والأيام التي كان يصومها، وكأنه أراد أن يجعل الختام بصيام رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وهو خير ختام، ثم أورد باب صوم الاثنين والخميس، والمناسبة أنه بعد أن ذكر باب كيف كان يصوم النبي – صلى الله عليه وسلم -، أورد باب في صوم الاثنين والخميس، وفي ذلك تناسق، في ترتيب أحاديث أبواب استحباب صوم النافلة، ثم باب في صوم العشر والمناسبة أنه في ذكر باب صوم العشر، التناسق من حيث أن هذه الأبواب كلها من زمرة صوم النوافل؛ وهي جميعا من المستحبات في صوم النافلة، ثم باب في فطر العشر لبيان الرخصة في الفطر، ثم باب في صوم عرفة بعرفة ومناسبة الباب للباب السابق أنه بعد ذكر باب فطر العشر، أورد باب صوم عرفة بعرفة، وفي ذلك تناسق في الترتيب الزمني، فبعد باب فطر العشر، أورد باب صوم عرفة بعرفة وهو منهي عنه للصائم، وكلا البابين في فطر العشر والنهي عن صوم عرفة للحاج بعرفة، ثم باب في صوم يوم عاشوراء والمناسبة بيان التناسق في الترتيب من حيث الخط الزمني فعاشوراء في شهر المحرم الذي يلي شهر ذي الحجة وهو آخر الأشهر الهجرية، وذلك فيه تناسق من حيث أن هذه الأيام كلها من الأيام التي يستحب صيامها، أما صوم يوم عرفة فيستحب صيامه لغير الحاج، ثم أورد باب صوم يوم عاشوراء، وأنه رُوي أن عاشوراء اليوم التاسع، وهذا ما سار عليه الإمام أبو داود – رحمه الله – في ذكر القول المشهور ثم يتبعه بما اختلف فيه العلماء، ثم أورد فضل صوم عاشوراء، والفضل يُعد متمما وختاما لما يتعلق بصوم عاشوراء، باب في فضل صوم يوم وفطر يوم، والمناسبة بيان التناسق في الانتقال من فضل عاشوراء إلى الأفضل وهو أحب الصِّيام إلى الله، ثم باب في صوم الثلاث من كل شهر واستحباب صوم الثلاث من كل شهر، صوم الثلاث في أيام الليالي البيض، وفي ذلك تناسق في بيان أبواب الصوم المستحب واستيعابها، ثم باب النية في الصوم والمناسبة أن هنالك اختلاف نية صوم النافلة عن الصوم الواجب، ثم أورد مسائل تتعلق بالصيام المستحب، مثل صوم المرأة بغير إذن زوجها تطوعا، والصائم يُدعى إلى وليمة، وكل ذلك من متعلقات أبواب استحباب صوم النافلة.
المطلب الثالث: النَّسق البنائي لأبواب الاعتكاف
الباب السابع والسبعون: باب الاعتكاف
الاعتكاف: “من عَكَفَ وهو إقبالك على الشيء لا تصرف عنه وجهك”[94]. وشرعا: “المكث في المسجد من شخص مخصوص بصفة مخصوصة”[95]. ومناسبة الباب للباب السابق أنه بعد ختام كتاب الصيام بدأ بباب الاعتكاف والأشهر أنه يكون بعد صيام؛ ثم بيّن مكانه مما يحتاجه المعتكف وما يتعلق به من دخول المعتكف البيت وعيادة المريض، أو ما يعرض له – مما يشترط له – النظافة والاغتسال مثل الحيض والاستحاضة.
الباب الثامن والسبعون: باب أين يكون الاعتكاف
ومناسبة الباب للباب السابق أنه بعد باب الاعتكاف، جاء بباب أين يكون الاعتكاف، وفي ذلك تناسق من حيث الترتيب بين الباب وما يتبعه من بيان مكانه، وهذا من أجل استيعاب باب الاعتكاف وبيان تفاصيله.
الباب التاسع والسبعون: باب المعتكف يدخل البيت لحاجته
ومناسبة الباب للباب السابق أنه بعد باب أين يكون الاعتكاف، أورد باب المعتكف يدخل البيت لحاجته، وفي ذلك بيان لأحكام الاعتكاف، وما يجوز له أثناء الاعتكاف، وفي ذلك تناسق بين أبواب الاعتكاف بيانا واستكمالا له.
الباب الثمانون: باب المعتكف يعود المريض
أي يمر مرورًا مثل هيئة هو عليها فلا يعرج أي لا يميل عن الطريق إلى الجوانب “يسأل عنه” أي عن المريض[96]. ومناسبة الباب للباب السابق أنه بعد باب المعتكف يدخل البيت لحاجته، أورد باب المعتكف يعود المريض وفي ذلك تناسق؛ من حيث أن الاعتكاف قد يبطله بعض الأمور مثل دخول البيت، أو عيادة مريض، وهذا من باب استيفاء ما يتعلق بالمعتكف من أحكام.
الباب الحادي والثمانون: باب المستحاضة تعتكف
ومناسبة الباب للباب السابق أنه بعد باب المعتكف يعود المريض، أورد باب المستحاضة تعتكف، وفي ذلك تناسق في أنه بعد بيان حال المعتكف في عيادة المريض، بيَّن حال المرأة المستحاضة، وذلك لبيان تفاصيل ما يتعلق بالاعتكاف.
وفي المطلب الثالث: النَّسق البنائي لأبواب الاعتكاف
أورد الإمام أبو داود – رحمه الله – في هذا المطلب خمسة أبواب في الاعتكاف، ومناسبة الباب لسابقه أنه بعد ختام كتاب الصيام بدأ بباب الاعتكاف والأشهر أنه يكون بعد صيام؛ وبيّن مكانه وما يتعلق به من دخول المعتكف البيت وعيادة المريض، ثم أين يكون الاعتكاف والمناسبة لسابقه، وفيه تناسق من حيث الترتيب بين الباب وما يتبعه من بيان مكانه، لاستيعاب باب الاعتكاف وبيان تفاصيله، مثل دخول البيت والمناسبة في ذلك تتمة البيان وفي التناسق استكمال لأحكام الاعتكاف، ثم حكم الاعتكاف للمستحاضة، وفي ذلك تناسق في أنه بعد بيان حال المعتكف في عيادة المريض، بيَّن حال المرأة المستحاضة، وذلك لبيان تفاصيل ما يتعلق بالاعتكاف.
الخاتمة: وفيها أبرز النتائج والتوصيات.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وفي نهاية هذا البحث نرجو الله – عز وجل – أن يكون عملا نافعا متقبلا، والله ولي التوفيق.
نتائج البحث:
هذا وقد توصل الباحثان إلى النتائج الآتية:
أشار السؤال الأول إلى مفهوم النَّسق البنائي اصطلاحا.
وكانت النتيجة الآتي:
النَّسق البنائي: هو النظام الذي يضم أجزاء المكون بعضها إلى بعض على جهة الثبوت بروابط منتظمة مطردة، تسهم في فهم دلالات النصوص، ومعرفة دورها الوظيفي.
أشار السؤال الثاني إلى علاقة النَّسق البنائي بالمناسبة.
وكانت النتيجة الآتي:
نرى أن النَّسق والمناسبة بينهما تشابه من حيث الربط بين مكونات متعددة في نظم واحد متناسق بين المكونات، أما الفرق بين النَّسق والمناسبة أن النَّسق يكون بين مكونات متعددة تنتظم في نسق واحد، أما المناسبة فتكون بين أمرين، وذلك لبيان العلاقة بينهما من حيث انتظامها في السياق والسباق.
أشار السؤال الثالث إلى النَّسق البنائي لأبواب كتاب الصوم في سنن أبي داود – رحمه الله -.
وكانت النتيجة الآتي:
اهتم الإمام أبو داود – رحمه الله – بالنَّسق البنائي لأبواب الصيام، والناظر في سنن أبي داود – رحمه الله – يلاحظ أن المناسبات بين الأبواب تظهر بشكل واضح بين كل باب والباب الذي يليه، وكأن كل باب خرزة في عقد منسوج بغاية العناية والاتقان، وفي ذلك اتصال بديع بين كل باب والذي يليه كما اتصل بما سبقه من الأبواب؛ وفق النسق الزمني في ترتيب الأبواب.
التوصيات: بعد انتهاء البحث، يوصي الباحثان بالآتي:
1- المتابعة لدراسة سنن أبي داود لمعرفة النَّسق البنائي لأبواب الكتاب كاملا.
2 – الاهتمام بدارسة الكتب الستة لمعرفة النَّسق البنائي لأبوابها.
3 – المقارنة بين الكتب الستة من حيث النَّسق البنائي لأبوابها.
4 – الدراسة المتعمقة لبيان أثر النَّسق البنائي في الحكم على الحديث.
المصادر والمراجع
إبراهيم، د. زكريا إبراهيم، مشكلة البنية أو أضواء على البنيوية، مكتبة مصر، ط: 1990م.
ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق: طاهر الزاوي، ومحمود الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، ١٣٩٩هـ – ١٩٧٩م.
ابن حجر، أحمد بن علي (٧٧٣ – ٨٥٢ هـ)، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، دار المعرفة، بيروت، ١٣٧٩هـ.
ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي الظاهري (ت: 456 هـ)، المحلى بالآثار، تحقيق: عبد الغفار البنداري، دار الفكر، بيروت، د. ط، د. ت.
حمداوي، جميل حمداوي، نحو نظرية أدبية ونقدية جديدة (نظرية الأنساق المتعددة)، ط1، 2016 م.
الحميدي، محمد عبد الكريم، السياق والأنساق، دار النفائس، ط 2013م.
الخَطَّابي، حمد بن محمد بن إبراهيم (ت: 388هـ)، معالم السنن، شرح سنن أبي داود، تحقيق: محمد الطباخ، المطبعة العلمية، ط1، حلب1351هـ – 1932م.
أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني (202-275 هـ)، سنن أبي داود، دار الكتاب العربي. بيروت، لبنان.
أبو داود، رسالة أبي داود إلى أهل مكة، تحقيق: محمد بن لطفي الصباغ، دار العربية، بيروت.
الرازي، محمد بن أبي بكر (ت: ٦٦٦هـ)، مختار الصحاح، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، بيروت، ط:5، ١٤٢٠هـ – ١٩٩٩م.
الراغب الأصفهانى، الحسين بن محمد (ت: ٥٠٢هـ)، المفردات في غريب القرآن، تحقيق: صفوان الداودي، دار القلم، دمشق، ط1: ١٤١٢هـ.
الرافعي، مصطفى صادق (ت ١٣٥٦هـ)، تاريخ آداب العرب، دار الكتاب العربي.
الزَّبيدي، محمّد مرتضى الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: جماعة من المختصين، وزارة الإرشاد، الكويت، د. ط، د. م.
الزحيلي، د. وَهبة مصطفى، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، دمشق، ط4.
الزركشي، بدر الدين محمد (ت: ٧٩٤هـ)، البرهان في علوم القرآن، محمد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة عيسى الحلبي، ط1، ١٣٧٦هـ – ١٩٥٧م.
السبكي، محمود محمد خطاب (ت 1352 هـ)، المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود، تحقيق: أمين خطاب، مطبعة الاستقامة، القاهرة، ط1 ١٣٥١هـ – ١٣٥٣هـ.
سلطان، جاسم سلطان، النَّسق القرآني ومشروع الإنسان قراءة قيمية راشدة، مركز الوجدان الحضاري، بيروت، ط1، 2018م.
السندي، محمد بن عبد الهادي التتوي، (ت: ١١٣٨هـ)، السندي على ابن ماجه، دار الجيل، بيروت، د. ط.
السندي، أبو الحسن السندي، فتح الودود في شرح سنن أبي داود، تحقيق: محمد الخولي، مكتبة لينة، مصر، مكتبة أضواء المنار، المدينة المنورة، السعودية، ط1، ١٤٣١هـ – ٢٠١٠م.
السهارنفوري، خليل أحمد (ت: ١٣٤٦ هـ)، بذل المجهود في حل سنن أبي داود، عناية: د. تقي الدين الندوي، مركز الندوي للبحوث والدراسات الإسلامية، الهند، ط1، ١٤٢٧ هـ – ٢٠٠٦ م.
السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر (ت ٩١١هـ)، الإتقان في علوم القرآن، محمد أبو الفضل، الهيئة المصرية للكتاب، ط: ١٣٩٤هـ/ ١٩٧٤ م.
الشدياق، أحمد فارس يوسف، (ت:1887م)، الجاسوس على القاموس، مطبعة الجوائب،
قسطنطينية، ط:1299هـ.
الشوكاني، محمد بن علي بن محمد (ت: ١٢٥٠هـ)، نيل الأوطار، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، دار الحديث، مصر، ط1، ١٤١٣هـ – ١٩٩٣م، (1/ 139).
الصاحب، إسماعيل بن عباد (٣٢٦هـ – ٣٨٥هـ)، المحيط في اللغة، محمد حسن آل ياسين، عالم الكتب، بيروت، ط1، ١٤١٤هـ – ١٩٩٤م.
الطيبي، الحسين بن عبد الله الطيبي (ت: 734هـ)، شرح الطيبي على مشكاة المصابيح، تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي، مكتبة نزار الباز مكة المكرمة – الرياض، ط1، ١٤١٧ هـ – ١٩٩٧ م.
أبو عُبيد، القاسم بن سلاّم الهروي (ت: ٢٢٤هـ)، غريب الحديث، تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان.
العزايزة، عامر محمد محمود، وحدة النَّسق في الجامع الصحيح للإمام البخاري دراسة تأصيلية تطبيقية ” كتاب النكاح أنموذجا”، المشرف: د. محمد عيد الصاحب، الجامعة الأردنية، كلية الدراسات العليا.
العظيم آبادي، شرف الحق العظيم آبادي (ت: ١٣٢٩)، عون المعبود شرح سنن أبي داود، المطبعة الأنصارية، دهلي، الهند.
العيني، محمود بن أحمد (ت: ٨٥٥ هـ)، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، تحقيق: محمد منير أغا وآخرون، ودار الفكر، بيروت.
الغدامي، عبد الله الغذامي، النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية، المركز الثقافي العربي، المغرب، دار البيضاء، ط3، 2005م.
ابن فارس، أحمد بن فارس (ت: 395هـ)، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام هارون، دار الفكر، ط: 1399هـ – 1979م.
ابن فارس، أحمد بن فارس الرازي، (ت: ٣٩٥هـ)، مجمل اللغة، تحقيق: زهير عبد المحسن، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: 2، ١٤٠٦ هـ – ١٩٨٦م.
الفراهيدي، الخليل بن أحمد (ت: ١٧٠هـ)، العين، تحقيق: د. مهدي المخزومي، ود إبراهيم السامرائي، دار الهلال، بيروت.
فضل، صلاح فضل، نظرية البنائية في النقد الأدبي، دار الشروق، القاهرة، ط1، 1419هـ – 1998م.
القاري، علي بن سلطان محمد، (ت: ١٠١٤هـ)، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، دار الفكر، بيروت، ط1، ١٤٢٢هـ – ٢٠٠٢م، 4/ 1376.
القرطبي، أحمد بن عمر بن إبراهيم (٥٧٨ – ٦٥٦ هـ)، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، تحقيق: محيي الدين ميستو، وآخرون، دار ابن كثير، دمشق، ط1، ١٤١٧هـ – ١٩٩٦م.
قلعجي وقنيبي، محمد قلعجي وحامد قنيبي، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس، ط2، ١٤٠٨هـ – ١٩٨٨م.
الكاندهلوي، محمد زكريا بن يحيى (ت:1402هـ)، الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، تحقيق: د. ولي الدين بن تقي الدين الندوي، دار البشائر، بيروت، ط1، ١٤٣٣هـ – ٢٠١٢م.
المباركفوري، محمد عبد الرحمن (ت: 1353هـ)، جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي، دار الكتب العلمية.
مصطفى، إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، دار الدعوة، القاهرة.
ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي (ت: ٧١١هـ)، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط3: ١٤١٤هـ.
مهيدات، د. عبد الله مهيدات، النَّسق البنائي في كتاب الطهارة بين سنن أبي داود وجامع الترمذي، بإشراف الأستاذ الدكتور محمد الطوالبة، قسم أصول الدين، جامعة اليرموك.
النووي، محيي الدين يحيى بن شرف النووي، المجموع شرح المهذب، تحقيق: لجنة من العلماء، مطبعة التضامن، القاهرة، ط:١٣٤٤ – ١٣٤٧ هـ.
النووي، محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت: ٦٧٦هـ)، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، دار إحياء التراث العربي، بيرت، ط2، ١٣٩٢هـ.
[1][سورة الحجر: 9]
[2]أبو داود، رسالة أبي داود إلى أهل مكة، تحقيق: محمد بن لطفي الصباغ، دار العربية، بيروت، ص35.
[3]مهيدات، د. عبد الله مهيدات، النسق البنائي في كتاب الطهارة بين سنن أبي داود وجامع الترمذي، بإشراف الأستاذ الدكتور محمد الطوالبة، قسم أصول الدين، جامعة اليرموك، وقد تمت مناقشة هذه الرسالة بتاريخ 26-5-2021م.
[4] السوالمة، محمد عبد الله السوالمة، السياق وأثره في فهم الحديث النبوي دراسة نظرية تطبيقية، رسالة دكتوراه مقدمة للجامعة الأردنية، إشراف الدكتور محمد عيد محمود الصاحب، الجامعة الأردنية، كلية الدراسات العليا، 2013م، ص13.
[5]انظر: ابن سيده، علي بن إسماعيل (ت: ٤٥٨هـ)، المخصص، تحقيق: خليل إبراهيم جفال، دار إحياء التراث العربي- بيروت، ط:1، ١٤١٧هـ ١٩٩٦م، (2/ 192).
[6] الفراهيدي، العين، (8/ 382).
[7]ابن منظور، محمد بن مكرم بن على ابن منظور (ت٧١١هـ)، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط:3، 1414 هـ، فصل النون، (10/ 352-353).
[8]ابن جني، عثمان بن جني الموصلي (ت392هـ)، الخصائص، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط:4، باب القول على البناء، 1/38..
[9]انظر: إبراهيم، د. زكريا إبراهيم، مشكلة البنية أو أضواء على البنيوية، مكتبة مصر، ط: 1990م، ص 30.
[10]انظر: فضل، صلاح فضل، نظرية البنائية في النقد الأدبي، دار الشروق، القاهرة، ط1، 1419هـ – 1998م، ص122.
[11]انظر: العنبر، عبد الله العنبر، النظريات البنائية بين النموذج والتحولات النصية، مجلة: دراسات، العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد:45، العدد: 2، الجامعة الأردنية، ص185.
[12]العنبر، النظريات البنائية، ص192.
[13]انظر: العنبر، عمر عبد الله، سلطة النص وآفاق التجاوز في ضوء النقد البنائي، رسالة ماجستير، اللغة العربية وآدابها، الجامعة الأردنية، ط: عام2010م، ص47.
[14]الشدياق، أحمد فارس يوسف، (ت1887م)، الجاسوس على القاموس، مطبعة الجوائب، قسطنطينية، ط:1299هـ، ص90.
[15]حمداوي، جميل حمداوي، نحو نظرية أدبية ونقدية جديدة (نظرية الأنساق المتعددة)، ط1، 2016 م، ص8.
[16]انظر: فضل، صلاح فضل، نظرية البنائية في النقد الأدبي، دار الشروق، القاهرة، ط1، 1419هـ – 1998م، ص122.
[17]السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر (ت: ٩١١هـ)، الإتقان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل، الهيئة المصرية للكتاب، ط: ١٣٩٤هـ/ ١٩٧٤ م، 1/48.
[18]سلطان، جاسم سلطان، النسق القرآني ومشروع الإنسان قراءة قيمية راشدة، ط1، 2018م، مركز الوجدان الحضاري، بيروت، ص15.
[19]الحميدي، محمد عبد الكريم، السياق والأنساق، دار النفائس، 2013م، ص 21.
[20]الغدامي، عبد الله الغذامي، النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية، المركز الثقافي العربي، المغرب، دار البيضاء، ط3، 2005م، ص77.
[21]الرافعي، مصطفى صادق (ت ١٣٥٦هـ)، تاريخ آداب العرب، دار الكتاب العربي، (2/ 140).
[22]العزايزة، عامر محمد محمود، وحدة النسق في الجامع الصحيح للإمام البخاري دراسة تأصيلية تطبيقية ” كتاب النكاح أنموذجا”، المشرف: د. محمد عيد الصاحب، الجامعة الأردنية، كلية الدراسات العليا، عمان، الأردن، ص23.
[23]مهيدات، النسق البنائي، ص27.
[24]ابن فارس، مقاييس اللغة، (5/ 423).
[25]الزَّبيدي، محمّد مرتضى الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: جماعة من المختصين، وزارة الإرشاد، الكويت، د. ط، د. م، (4/ 265).
[26]مصطفى، إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، دار الدعوة، القاهرة، (2/ 916).
[27]البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، 1/6.
[28]مُسلم، مصطفى مُسلم محمد (1421هـ – 2000م)، مباحث في التفسير الموضوعي، ط3، دمشق، دار القلم، ص58.
[29]الزركشي، بدر الدين محمد (ت: ٧٩٤هـ)، البرهان في علوم القرآن، محمد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة عيسى الحلبي، ط1، ١٣٧٦هـ – ١٩٥٧م، (1/ 60).
[30]السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، 3/369.
[31]البقاعي، نظم الدرر، 1/6.
[32]انظر: العيني، محمود بن أحمد (ت: ٨٥٥هـ)،
عمدة القاري شرح صحيح البخاري، تحقيق: محمد منير أغا وآخرون، ودار الفكر، بيروت، 4/276.
[33]العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، (1/ 228).
[34]عبد الله مهيدات، أ.د محمد طوالبة، النسق البنائي لأبواب قضاء الحاجة والوضوء في سنن أبي داود، دراسة تطبيقية، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات، IUG Journal of Islamic Studies (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0
[35]قال الكاندهلوي: التراجم هي ما ترجم بهمن الكتب والأبواب، جمع ترجمة، وسُمِّي بالتراجم؛ لأنه مترجِم عمَّا بعده؛ لأن ما يذكر في الباب مثلًا تنبئ عنه الترجمة وتُبَيِّنُهُ، الكاندهلوي، محمد زكريا بن يحيى الكاندهلوي (ت: ١٤٠٢)، الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، تحقيق: د. ولي الدين بن تقي الدين الندوي، دار البشائر، بيروت، ط1، ١٤٣٣هـ – ٢٠١٢م، (1/ 101).
[36]السبكي، محمود محمد خطاب (ت 1352 هـ)، المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود، تحقيق: أمين خطاب، مطبعة الاستقامة، القاهرة، ط1 ١٣٥١هـ – ١٣٥٣هـ، (10/ 23).
[37]عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: “مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ”، أبو داود، السنن، 2/173، حديث رقم: 2046.
[38]السهارنفوري، خليل أحمد، (ت: ١٣٤٦ هـ)، بذل المجهود في حل سنن أبي داود، عناية: د. تقي الدين الندوي، مركز الندوي للبحوث والدراسات الإسلامية، الهند، ط1، ١٤٢٧ هـ – ٢٠٠٦ م، (8/ 422).
[39][سورة البقرة: 183].
[40][سورة البقرة: 184].
[41]أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر: عن ابن عمر – رضي الله عنهما – بلفظ: نسخت هذه الآية {وعلى الذين يطيقونه} التي بعدها {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}”، المباركفوري، محمد عبد الرحمن (ت: 1353هـ)، جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي، دار الكتب العلمية، 2/70.
[42]العظيم آبادي، محمد أشرف بن أمير بن علي (ت: 1329هـ)، عون المعبود شرح سنن أبي داود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، 1415هـ، (6/308). السهارنفوري، بذل المجهود، 8/433.
[43]انظر الخَطَّابي، حمد بن محمد بن إبراهيم (ت388هـ)، معالم السنن، شرح سنن أبي داود، تحقيق: محمد الطباخ، المطبعة العلمية، ط1، حلب1351هـ – 1932م، (2/ 93).
[44]ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق: طاهر الزاوي، ومحمود الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، ١٣٩٩هـ – ١٩٧٩م، 4/ 124.أبو عُبيد، القاسم بن سلاّم الهروي (ت ٢٢٤هـ)، غريب الحديث، تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان، 2/74.
[45]العظيم آبادي، عون المعبود، 2/269.
[46] المرجع السابق، 2/269.
[47]السهارنفوري، بذل المجهود، (8/ 457).
[48]السهارنفوري، بذل المجهود، (8/ 457).
[49]المرجع السابق، (8/ 457).
[50]العظيم آبادي، عون المعبود، 2/271.
[51]قلعجي وقنيبي، محمد قلعجي وحامد قنيبي، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس، ط2، ١٤٠٨هـ – ١٩٨٨م، ص265.
[52]السهارنفوري، بذل المجهود، (8/ 467).
[53]ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (٧٧٣ – ٨٥٢ هـ)، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، دار المعرفة، بيروت، ١٣٧٩هـ. (4/ 129).
[54]السُّحُور: من السَحَر وهو أول مآخير الليل، وذلك ما بين الليل إلى قريب من وقت السَحَر، ابن منظور، لسان العرب، (12/ 111).
[55]قلعجي، معجم لغة الفقهاء، (ص242).
[56]ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، 3/346.
[57]انظر: القرطبي، أحمد بن عمر بن إبراهيم (٥٧٨ – ٦٥٦ هـ)، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، تحقيق: محيي الدين ميستو، وآخرون، دار ابن كثير، دمشق، ط1، ١٤١٧ هـ – ١٩٩٦ م، 3/153.
[58]الراغب الأصفهانى، الحسين بن محمد (ت ٥٠٢هـ)، المفردات في غريب القرآن، تحقيق: صفوان الداودي، دار القلم، دمشق، ط1– ١٤١٢هـ، (ص796).
[59]أبو داود، سليمان بن الأشعث (ت 275هـ)، سنن أبي داود، تحقيق: شعَيب الأرنؤوط، الرسالة، ط:1، 1430هـ – 2009م، 2/277.
[60]روى أبو داود بسنده عن ابن عمر كان النبي – صلى الله عليه وسلم – إذا أفطر قال: “ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ”. أبو داود، السنن، 2/278.
[61]انظر: ابن حجر، فتح الباري، 4/235.
[62]روى أبو داود بسنده عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم “نَهى عَنْ الْوِصَالِ” قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله قال: “إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى”، الوصال: هو تتابع الصيام في يومين أو أكثر من غير إفطار بالليل. السهارنفوري، بذل المجهود، (8/ 501). قال ابن قدامة في “المغني”: “والوصال مكروه في قول أكثر أهل العلم”، ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن محمد (٥٤١ – ٦٢٠ هـ)، المغني، تحقيق: عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، وعبد الفتاح الحلو، دار عالم الكتب، الرياض، ط3 ١٤١٧ هـ – ١٩٩٧ م، 4/436.قال النووي: الوصال مكروه بلا خلاف عندنا، ونص الشافعي يدل كراهة التحريم، النووي المجموع، (6/357) .
[63]روى أبو داود بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -:”مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ”، أبو داود، السنن، 2/279.والمراد بقول الزور الكذب، والجهل السفه، والعمل به أي بمقتضاه، ابن حجر، فتح الباري، (4/ 117).قال النووي: “فلو اغتاب في صومه عصى ولم يبطل صومه عندنا، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والعلماء كافة، إلا الأوزاعي فقال يبطل الصوم بالغيبة ويجب قضاؤه”، وقال ابن حزم: ويبطل الصوم بالكذب، والغيبة، والنميمة”. النووي، محيي الدين بن شرف النووي (ت ٦٧٦ هـ)، المجموع شرح المهذب، تحقيق: لجنة من العلماء، مطبعة التضامن، القاهرة، ط:١٣٤٤ – ١٣٤٧ هـ، 6/ 356. ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي الظاهري (ت: 456 هـ)، المحلى بالآثار، تحقيق: عبد الغفار البنداري، دار الفكر، بيروت، د. ط، د. ت، (4/ 304).
[64]فذهب الشافعية والحنابلة إلى: ويكره السواك للصائم بعد الزوال أي من وقت صلاة الظهر إلى أن تغرب الشمس، المالكية والحنفية: لا يكره السواك للصائم مطلقاً لعموم الأحاديث في استحباب السواك. الزحيلي، د. وَهْبَة مصطفى، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، دمشق، ط4، (1/ 456). وقال الشوكاني: الحق أنه يستحب السواك للصائم أول النهار وآخره، وهو مذهب جمهور الأئمة. الشوكاني، محمد بن علي بن محمد (ت: ١٢٥٠هـ)، نيل الأوطار، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، دار الحديث، مصر، ط1، ١٤١٣هـ – ١٩٩٣م، (1/ 139).
[65]روى أبو داود بسنده عن النبي- صلى الله عليه وسلم – “أنه أمر بِالْإِثْمِدِ الْمُرَوَّحِ (الكحل المُطَيَّب بالمِسْك) عند النوم، وقال: لِيتقه الصائم”، أبو داود، السنن، 2/282، حديث رقم 2377.
[66]السهارنفوري، بذل المجهود، (8/ 531).
[67]العظيم آبادي، عون المعبود، 2/282.
[68]الخَطَّابي، معالم السنن، 2/112.
[69]العيني، عمدة القاري، 11/8.
[70]السهارنفوري، بذل المجهود، (8/ 543).
[71]السهارنفوري، بذل المجهود، (8/ 571).
[72]العيني، عمدة القاري، 11/46.
[73]الطيبي، الحسين بن عبد الله الطيبي (ت: 734هـ)، شرح الطيبي على مشكاة المصابيح، تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي، مكتبة نزار الباز مكة، الرياض، ط1، ١٤١٧ هـ – ١٩٩٧ م، 5/1599.
[74][سورة البقرة: 184]
[75]الرازي، مختار الصحاح، ص164.
[76]الرازي، مختار الصحاح، ص164.
[77]العظيم آبادي، عون المعبود، 2/279.
[78]السهارنفوري، بذل المجهود، (8/ 632).
[79]السندي، أبو الحسن السندي، فتح الودود في شرح سنن أبي داود، تحقيق: محمد الخولي، مكتبة لينة، مصر، مكتبة أضواء المنار، المدينة المنورة، السعودية، ط1، ١٤٣١هـ – ٢٠١٠م، (2/ 678).
[80]العظيم آبادي، عون المعبود، 2/300.
[81]السندي، أبو الحسن السندي، فتح الودود في شرح سنن أبي داود، تحقيق: محمد الخولي، مكتبة لينة، مصر، ط1، ١٤٣١هـ – ٢٠١٠م، (2/ 678).
[82]العيني، عمدة القاري، (6/ 291).
[83]ابن حجر، فتح الباري، 2/460.
[84]روى أبو داود بسنده عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني: أيام العشر قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء”، أبو داود، السنن، 2/301.
[85]السندي، محمد بن عبد الهادي التتوي، (ت: ١١٣٨هـ)، السندي على ابن ماجه، دار الجيل، بيروت، د. ط، 1/528.
[86]الخَطَّابي، معالم السنن، (2/ 131).
[87]قلعجي، معجم لغة الفقهاء، (ص301).
[88]الخَطَّابي، معالم السنن، 2/129.
[89]النووي، يحيى بن شرف النووي (ت ٦٧٦هـ)، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط2، ١٣٩٢هـ، 8/39.
[90]قلعجي، معجم لغة الفقهاء، (ص97).
[91]انظر: العظيم آبادي، عون المعبود، 2/304.
[92]العظيم آبادي، عون المعبود، 2/305.
[93]الخَطَّابي، معالم السنن، (2/ 134)
[94]الفراهيدي، العين، (1/ 205).
[95]الزحيلي، د. وَهْبَة مصطفى، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، دمشق، ط4، 1/182.
[96]الطيبي، فتح الودود، (2/ 702).
Abu Dawood، The Schematic Structure، Fasting Chapter
The structural pattern is the logical link between the chapters in a regular sequential manner. As they are the building blocks، they are built in a regular and sequential sequence، and so is the constructive pattern، so the chapters are sequential in a logical sequence. Imam Abu Dawud took care of the structural system in his book Al- Sunan، and this contributed to revealing the doctrine of Imam Abi Dawud in some jurisprudential issues، clarifying the jurisprudential schools of thought، clarifying the points of agreement and disagreement between scholars، and clarifying his doctrine in various hadiths، and in that is a deep understanding of the science of hadith and its jurisprudence. And the doctrines of modern scholars، and how systems are in the books of modern scholars